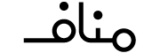بعد انتظار طويل قمتُ بقراءة رواية الجوع للفائز بنوبل للآداب في العام 1920 النرويجي كنوت هامسون (1859 – 1952)، لتفاجئني بالأفكار التي تحملها، والتي كنتُ أظن أنها وليدة التعقيد البالغ الذي وصلت إليه الحياة الإنسانية في سنواتنا الأخيرة، قال كل شيءٍ في روايته دون أن يقول شيئاً، ولكنه جعل نفس الأفكار التي كان ينوي كتابتها – ربما – تدور في رأسك رغماً عنكَ، لتقضي الرواية قائلاً لبطلها “اِسرق لا أحد سواك يحق له ذلك”.
أحداث الرواية تدور ببساطة حول صحفي نروجي يقضي أيامه باحثاً عن طريقة لتأمين ثمن طعامه، وباستثناء المرات القليلة التي يملك فيها المال الكافي، فإنه في معظم الرواية لا يأكل، ويصف بقسوة ما يصيب الجسد والعقل من اضطرابات نتيجة البقاء لأيامٍ دون طعام، لا شيءَ مثيراً للمتعة في الأحداث نفسها، حيث لا تعتمد الرواية على الحبكة وتصاعد الحدث، إنما مجرد ما يشبه المذكرات لأيامٍ تبدو بالغة الصعوبة.
المثير في الرواية ليس فكرة الجوع بحد ذاتها، أو فكرة الحرمان المادي، بل هو الأثر الذي تركته الحضارة الإنسانية المصطنعة على الإنسان الفرد، حيث يبدّي البطل عدة مراتٍ حفاظه على أصول اللباقة والحفاظ على صورته كشخصٍ محترم على إمكانية إنهاء الجوع والعوز المادي الذي يراوده.
في أحد أجزاء الرواية الأولى كان البطل يحاول كتابة مقالٍ يسميه (بحث في المعرفة الفلسفية)، ورغم أن أي مقالٍ يقوم بكتابته يهدف بشكلٍ مباشر إلى الحصول على بعض النقود، إلا أنه يبرر عند تأخره عن كتابة المقال بسبب نسيانه قلمه في مكتب الرهونات، في المكان الذي رهن فيه صدارته كي يعطي متسولاً نقوداً، يبرر كتابة المقال وضرورة الاستعجال بكتابته بأن “على مقال (بحث في المعرفة الفلسفية) هذا تتعلق أمور كبيرة، فمن يدري! فلعله يكون لسعادة الكثير من الناس. وقلتُ في نفسي (ربما فيه عون عظيم لبعض الشبان)”.
تسلط الرواية الضوء على نقطة هامة اليوم تبدو أكثر وضوحاً بكثير من ذلك الزمان ربما، وأكثر وضوحاً بالنسبة لي كوني أعمل في مجال الصحافة، هذه النقطة هي كون الحضارة الإنسانية في أوج تقدمها وفي ظل ما تظهره من تقديس للأفكار وللمفكرين (على الأقل الموتى منهم)، فإن المهن ذات الطابع الفكري هي تكاد تكون الأقل مردوداً مادياً بين مهن الياقات البيضاء، ويزيد الأمر سوءاً كل ما كان الفرد أقل ارتباطاً بالمؤسسات.
في أحد مشاهد الرواية الأخيرة تصل للبطل رسالة فيها مبلغ من النقود لا يعلم من أرسلها، ولكنه بدلاً من أن ينفقها في تدبير أموره يذهب ليرميها في وجه صاحبة الفندق التي طردته للتو بسبب تأخره عن دفع المترتب عليه، ودون أن يستغل امتلاكه للنقود للمكوث من جديد في الفندق، هذا المشهد، بما يمثله من استهتار الإنسان بنفسه لإرضاء الحاجة إلى التقدير الفارغ الذي تزرعه فينا معطيات الحياة المعاصرة من حولنا، يتكرر أمامنا كل يوم، إن لم نكن نحن من يقوم به.
الإنسان هو الكائن الوحيد الذي لا يستطيع العيش على هذا الكوكب دون نقود، تكررت هذه المقولة أمامي كثيراً في الفترة الأخيرة، وربما ترددها حولي كثيراً شجعني أكثر أن أكتب عن الجوع، كنتُ أظن أن الجوع الناجم عن عوزٍ مادي هو مجرد أسطورة، ولكن قراءتي لهذه الرواية تزامنت مع انتقالي جزئياً للعيش وحيداً في دمشق القديمة، لأكتشف تفاصيل حياة الكثير من أصدقائي الطلاب الذي يعيشون وحيدين، وأكتشف أن هناك بالفعل من ينام جائعاً بسبب عدم امتلاكه ثمن وجبة العشاء، وأن هؤلاء ليسوا من المشردين الذين نراهم في الطرقات يتسولون، شبان وشابات يرتدون الملابس المرتبة، ويتصرفون بطريقة لائقة ويستخدمون الحواسيب والهواتف المحمولة، هؤلاء هم مثقفو ومتعلمو مجتمعنا، هؤلاء من يُعتمد عليهم لبناء الحضارة في أرض بلدنا، وهؤلاء نفسهم الذين يهجرون هذا البلد كل يوم تاركين كل شيءٍ خلفهم، بالضبط كبطل الجوع.
لا أملك الكثير لأقوله عن الكتاب، ولكنه قال الكثير مما يدور في خلدنا، رغم بعده عنا بحوالي القرن، فإنه تكلم عن مأساة قديمة جديدة، ووجه كما نتمنى جميعاً بصقة في وجه حضارة وصلت إلى القمر وما زال فيها الكثير من الجياع.
النسخة التي قرأتها صادرة عن دار المدى ضمن سلسلة (مكتبة نوبل) ومترجمة من قبل محمود حسني العرابي الذي يبدو أنه اجتهد قليلاً في الترجمة، هذا الكتاب يحقق بجدارة مقولة (الأدب ليس ما يقال بل كيف يقال)، ولكن بالتأكيد فإن ما تقوله هذه الرواية يستحق الوقوف عنده مطولاً.