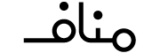أثناء غرقي في مقاطع إنستغرام، ظهر لي فيديو لفتاة لا تظهر على الشاشة، إنما فقط ظلها على الأرضية، وتقوم برفع قميصها ليظهر ظل ثديها. أثار الأمر فضولي – وحفزني كذكر طبعاً – لأفتح حسابها وأشاهد ما طبيعة بقية المحتوى الذي تنشئه، وكان كل محتواها عبارة عن إظهار ثدييها من خلف ستار لا أكثر ولا أقل: ظل على الجدار أو الأرضية، انعكاسهما على سطح قليل اللمعان والوضوح أو غير مسطح، ملابس شفافة بعض الشيء. عدد متابعي الحساب يزيد عن ثلاثمئة ألف على ما أذكر رغم كونه جديد نسبياً، أقل من سنة غالباً.
اكتشفت بفضل التأثير الذي تسببت به على خوارزمية إنستغرام الخاصة بي أن هناك الآلاف مثله، وبات هناك سؤال يطرح نفسه: لماذا يتابعون هذا الحساب؟ إن كانوا يريدون مشاهدة نساءٍ عاريات هناك مئات الملايين من الأفلام الإباحية المتوفرة على الإنترنت مجاناً، لماذا هذا التقشف ومشاهدة ظل ثدي بدلاً من تصفح الأفلام الإباحية ببساطة؟
ظل الواقع
رغم أن هذا النوع من المحتوى قد لا يعبّر عن معظم المحتوى الموجود اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه يتبع نفس المبدأ والتركيبة. منذ بروز تطبيق تيكتوك، باتت الفيديوهات القصيرة تهيمن على معظم شبكات التواصل الاجتماعي، وطغت حتى على طرق الاستخدام الأصلية لهذه الشبكات، التي وجدتْ نفسها مجبرة على التغيّر لتلائم إدمان التصفح اللانهائي بشكله الجديد، خصوصاً الانتقال من الصفحات الرئيسية التي تقدم لك المحتوى بشكل خطي، إلى التصفح عبر السحب للأعلى أو الجوانب والانتقال من منشور لآخر مباشرة دون ظهورها مؤرشفة كما هي حال الصفحة الرئيسية على فيسبوك أو تويتر مثلاً.
الفيديوهات المضحكة تحتل المرتبة الأولى بلا منازع، وحين نقول مضحكة فذلك لا يعني بالضرورة أنها ستتسبب فعلاً بالضحك، بل يعني أنها منشأة بشكل كوميدي يُفترض به أن يكون مضحكاً.
معظم الفيديوهات تتبع كذلك أسلوباً يشبه الفيديوهات المنزلية في مرحلة ما قبل شبكات التواصل الاجتماعي، أي إنها تصور مواقف حياتية يومية تنحرف عن مسارها الطبيعي نحو عبارة أو حركة أو مفارقة مضحكة، ولكنها على عكس الفيديوهات المنزلية ليست عفوية على الإطلاق في 99% من الحالات.
يكفي ببساطة أن نسأل من يصوّر الفيديو أو لماذا كان يصوّر أصلاً عند حصول الموقف لنكتشف أنها غير حقيقية، وغالباً هذا ليست اكتشافاً عظيماً، فلا أعتقد أن هناك من يدّعي أن فيديوهاته عفوية أصلاً.
ولكنها في الوقت نفسه ليست احترافية، بمعنى أنها لا تُصنع بذات طريقة إنشاء المسلسلات والعروض الكوميدية، حتى تلك التي تعتمد في بينتها على تقديم اسكتشات قصيرة غير مندرجة ضمن خط قصصي متكامل.
إضافة لانعدام الجودة والواقعية في هذه الفيديوهات، فإنها أيضاً تفتقد للأصالة، معظم الفيديوهات التي نشاهدها هي نسخة عن نسخة عن نسخة، ولا نعلم إن كانت النسخة الأصلية تحقق أياً من الشروط المذكورة سابقاً. وهكذا نحن أمام محتوى يفتقد للصدق – الشكلي على الأقل – ويفتقد للجودة، وليس جديداً أصلاً.
إذاً ما هي هذه الفيديوهات التي باتت تحتل نسبة كبيرة من المحتوى الذي نستهلكه بشكل يومي؟ إن كنّا نريد الضحك لماذا لا نشاهد واحداً من آلاف المسلسلات والأفلام الكوميدية المتوفرة بسهولة عبر الإنترنت؟ إن كنا نريد مشاهدة نساءٍ عاريات لماذا لا نشاهد مئات ملايين النساء العاريات على المواقع الإباحية؟ لماذا نرضى بمحتوى ينشؤه هواة يحوّلون أنفسهم لأبطال حياة وهمية تفيض بالمواقف المضحكة والعثرات الإيروتيكية؟
بالعودة إلى الفتاة صاحبة ظل الثدي، فإن معظم المحتوى الذي نشاهده على شبكات التواصل الاجتماعي لا يختلف عن محتوى هذه الفتاة؛ لا الكوميديا كوميدية ولا الواقع واقعي، فلا نحن نستهلك فنوناً مصنوعة بإتقان ولا نحن نعيش في الواقع ونشهد مواقف مضحكة تحصل معنا نحن.
ظل المعرفة
كان من المعروف أن متابعة وسائل الإعلام، خصوصاً محتواها غير الترفيهي، يزوّد المتلقي بثقافة سطحية، أي إنه يعرف القليل من المعلومات عن الكثير من المواضيع بدون أن يتعمق في أي منها، وحتى ضمن وسائل الإعلام نفسها، فإن الفارق ملحوظ بين من يستهلك المحتوى المقروء والمحتوى المرئي أو المسموع، وبكل الأحوال فإن هناك فارق لا يمكن إنكاره بين من يستقي ثقافته من وسائل الإعلام ومن يستقيها من الكتب.
لكن في العصر الحالي، الذي يمكن القول أنه بدأ منذ الانتشار الواسع لإنستغرام وترسّخ بعد دخول تيكتوك إلى المشهد كلاعب رئيسي، ظهرت ثقافة أكثر سطحية تعتمد على محتوى شبكات التواصل الاجتماعي، والذي تنتج جزءاً منه وسائل الإعلام التقليدية نفسها، بعد أن استسلمت لواقع انحصار استخدام الإنترنت بالنسبة لغالبية البشر في وسائل التواصل الاجتماعي، فباتت تختصر تقاريرها في فيديوهات لا يزيد طولها عن الدقيقة، وتخدش سطح الأمور قدر المستطاع بدون أي عمق كي لا تثير ملل المشاهد الذي تكفيه حركة إصبع كي يتجاوز الفيديو.
الفارق بين ثقافة جمهور الكتب وجمهور وسائل الإعلام أقل بكثير من الفارق بين ثقافة جمهور وسائل الإعلام وجمهور السوشيال ميديا، الأمر الذي جعل قراءة الأخبار اليوم أو متابعتها على التلفزيون مثلاً حكراً على الفئات السنية الأكبر و”المثقفين”، أياً كان تعريفهم في الوضعية الحالية.
آليات الإدراك لدى جمهور وسائل التواصل الاجتماعي باتت مختلفة، وأهم ما يميّزها هو الفترات الزمنية القصيرة، إذ أصبحت مدّة الانتباه المتواصل الممكنة لديهم شديدة القصر بسبب طبيعة المحتوى الذي يستهلكونه. من خلال عملي في التسويق الرقمي، بات اليوم من المحرّمات الحديث عن إنشاء فيديو يزيد طوله عن نصف دقيقة، وفي الحالات القصوى النادرة يمكن إنشاء فيديو مدته دقيقة، وإن كان ذلك ينطوي على رهان شديد الخطورة.
في الوقت نفسه هناك الكثير من منشئي المحتوى الناجحين يقدّمون محتوى تعليمي أو تثقيفي، ولكنهم مقيّدين بعاملين مهمّين: الأول هو قصر المدّة، مع استثناء يوتيوب ربما حيث ما زالت الفيديوهات الطويلة الخيار المفضل للمستخدمين، والثاني هو الإضحاك، حيث بات على منشئ المحتوى أن يكون قادراً على الترفيه عن المشاهد ولا يكتفي بتزويده بالمعلومة.
كيف يمكننا أن نقدّم معلومات مفيدة خلال أقل من دقيقة ونضحك المشاهد أو نرسم ابتسامة على وجهه في الوقت نفسه؟ الإجابة هي أنه لا يمكننا ذلك، وإن كان هناك محتوى تثقيفي استطاع تحقيق الشرطين، فإنه ببساطة لم يحقق الغاية، وهي إيصال المعلومة والحفاظ عليها في ذاكرة المتلقي.
قد تكون شبكات التواصل الاجتماعي مكاناً مناسباً لمتابعة آخر أخبار أصدقائنا وعائلاتنا، أو الترفيه عن أنفسنا حين لا يسمح وقتنا بمشاهدة مسلسل أو فيلم أو قراءة كتاب، ولكن إن فكّرنا ببعض الواقعية، فإنها بشكلها الحالي الذي رسم ملامحه صعود نموذج تيكتوك غير صالحة لأي فائدة.
لا يعود الأمر لمؤامرة أو مخطط شرير يسعى لتسطيح عقولنا، إنما ببساطة لأن هذا النموذج هو الوحيد القادر على تحقيق الأرباح الإعلانية في الوقت الحالي، سواءً لشبكات التواصل الاجتماعي نفسها أو لمنشئي المحتوى.
الخروج من الظل
متوسط الزمن الذي يقضيه المستخدم الواحد على إنستغرام يومياً هو حوالي 33 دقيقة، أي 16.5 ساعة في الشهر، ومتوسط الزمن الذي يستغرق القارئ العادي لقراءة 100 صفحة حوالي ثلاث ساعات، أي إنه يستطيع أن يقرأ حوالي 550 صفحة في متوسط زمن مشاهدة الفيديوهات على إنستغرام خلال شهر، أي كتابين إن اعتبرنا الرقم السائد لمتوسط حجم الكتب (250 صفحة) صحيحاً.
قد تبدو المعادلة أبسط من أن تطبّق، ولكن للخروج من الظل، الذي يتحول تدريجياً لظلمة مطبقة، لا بد من العودة إلى المربع الأول. استهلاك وسائل الإعلام التقليدية المتجهة نحو الهاوية لن يعوّض أو يخلق معرفة معمّقة بأي موضوع يهمّنا، ومحاولة إصلاح الأمور عبر متابعة حسابات “تعليمية” أو “تثقيفية” على شبكات التواصل الاجتماعي مثيرة للضحك.
الفارق بين الحالتين هي شخص أنهى السنة وفي جعبته 24 ألف فيديو قصير لم يعلق في ذاكرته – قصيرة الأمد مثل انتباهه – منها شيئاً، وشخص أنهى السنة وفي جعبته 24 كتاب. جميعاً يهتم بموضوع ما، وأياً كان هذا الموضوع – من كرة القدم والطهي إلى الفلسفة الحديثة والحوسبة الكمية – فلا بد أن هناك مئات الكتب عنه، وشئنا أم أبينا ليستْ هناك طريقة أفضل للتعمق في أي موضوع من قراءة الكتب.
لحسن حظنا فإن ذات التطوّر الذي أدى لظهور وسائل التواصل الاجتماعي جعل الكتب متوفرة بلا حدود، حمّل واحداً من مئات التطبيقات التي تتيح شراء وقراءة الكتب، ويمكن عبر تطبيقات مثل أبجد وتطبيق مؤسسة هنداوي قراءة آلاف الكتب بالمجان، ويكفي أن يكون أحد هذه التطبيقات على الهاتف لاستخدامها في تسجية الوقت أثناء الانتظار أو التنقل أو الملل.
في النهاية لا بد من الإشارة إلى أنني أنا نفسي لا أجد الكثير من النجاح في تحقيق هذه النقلة، بدأت عادة مشاهدة الفيديوهات القصيرة لدي مؤخراً كأسلوب تواصل مع الأصدقاء وأفراد العائلة الذين أتبادلها معهم وترفيه سهل المنال عند إفراغ أمعائي، ولكنها تسببت بأضرار كارثية.
أولاً اضطراب في النوم لا يبدو أن له حلاً ما دامت تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي موجودة على هاتفي، وثانياً اضطراب في أداء مهامي في العمل والكتابة لفترات طويلة بسبب انخفاض فترات الانتباه المتواصل الممكنة، وثالثاً شعور بوجودي في هوّة مظلمة أفتقد فيها لأي معلومات أو معرفة قيمة بخصوص أي موضوع كان، وعلى رأسه قضية فلسطين التي تشغلنا جميعاً هذه الأيام، والتي حين عدتُ للقراءة عنها في كتاب أدركتُ كم إن الصورة التي تصلني من إنستغرام عنها وأمثاله مشوّهة وملطّفة على تعبّر عن عمق الكارثة، كما هي حال أي شيءٍ نعتقد أننا نعرفه لأننا شاهدنا مقتطفات عنه.