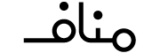لماذا نكتب؟ هذا السؤال يؤرّق كل من يكتب وكل من يحيط بمن يكتب، فالكتابة بالنسبة للعربي في ظل مختلف المعطيات المحيطة بها تبدو فعلاً عبثياً يخلو من أي فائدة تُرجى، فلا هو يجني مالاً ولا شهرةً ولا حتى وزناً في الحياة العامة، على المستوى السياسي خصوصاً. ولكن السؤال الذي يستجر مزيداً من الأرق بالنسبة لمن يكتب بالعربية هو “كيف نكتب؟”، وليس المقصود هنا العملية الإبداعية، إنما الجانب اللوجستي لفعلٍ مثل الكتابة.
تحت خط الفقر
في لقاء أجري معه سنة 2019، ورداً على سؤال بخصوص كتابته الصحفية في جريدة عكاظ وعمّا إذا كانت تؤثر على مخزونه الإبداعي، قال الروائي السعودي عبده خال: “المكافأة التي أحصل عليها من عكاظ تقيم أود حياتي”، وأضاف صاحب “ترمي بشرر” الفائزة بجائزة البوكر العربية أن دخله السنوي من 11 رواية بالكاد يبلغ 10 آلاف ريال سعودي (2600 دولار تقريباً).
حالة عبده خال ليست استثناءً، إنما تكاد تكون الوضع الطبيعي بالنسبة للكتاب العرب. في نفس العام، وفي لقاء مع العين الإخبارية، قال الروائي السوداني أمير تاج السر أن الطب هو العمل الذي يعيش منه، لأن “الكتابة في الوطن العربي لا يعتمد عليها في الحياة”.
ببعض المرونة، يمكن القول أنها ليست حالة خاصة بالوطن العربي أيضاً، وإن كانت أقل حدّة في الغرب، حيث يشير استبيان أجرته “نقابة المؤلفين” في الولايات المتحدة وشمل 5,699 مؤلفاً لديه أعمال منشورة إلى أن متوسط الدخل السنوي للمشاركين في الاستبيان بلغ 2,000 دولار أمريكي من عائدات الكتب نفسها، و5,000 دولار أمريكي من مختلف الأنشطة المرتبطة بالكتابة، ما يضعهم تحت خط الفقر البالغ 13,788 دولار في الولايات المتحدة.
سواءً أكان يعني هذا الأمر أن فقر الكتّاب حالة عالمية أم لا، لا يمكن هنا صرف النظر عن الفارق بين دخل الكتّاب في الولايات المتحدة والوطن العربي، حيث يبلغ دخل كاتب بحجم عبده خال ذات متوسط دخل الكتّاب الأمريكيين المشاركين في الاستبيان، والذي يعمل 35% منهم فقط في الكتابة بدوام كامل. هناك شبه انعدام للدخل الممكن للكتّاب العرب من تأليف الكتب وحده، اللهم سوى في حالات الفوز بالجوائز ذات المكافآت المرتفعة والتي في أفضل الأحوال تكفي لسد رمق الكاتب لسنة أو سنتين، إلى جانب الاستثناءات الأخرى مثل الكتّاب الذين يؤلفون المسلسلات التلفزيونية والأفلام إلى جانب الكتب.
كتّاب يوم الأحد
في رواية (سن الرشد) لجان بول سارتر يرد حديث بين ماتيو وإيفيش عمّا يسمّى “رسام أيام الأحد” و”كاتب يوم الأحد”، وكتّاب يوم الأحد هم “بورجوازيون صغار يكتبون كل عام قصة قصيرة أو خمس قصائد أو ستاً ليطعّموا حياتهم بشيء من المثالية. بدافع من المحافظة على الصحة”.
هل الكتّاب العرب بغالبيتهم العظمى كتاب يوم الأحد؟ هناك فارق أساسي بين الحالتين ربما، فالكاتب الأوروبي، على الأقل في عصر رواية (سن الرشد)، أي منتصف ثلاثينيات القرن الماضي، كان لديه خيار التفرغ للكتابة، إن كان كاتباً جيداً بطبيعة الحال، بينما الكاتب العربي في عصرنا الحالي، سواءً أكان جيداً أم رديئاً، لا خيار أمامه للتفرّغ للكتابة، ومعظم الخيارات الأقرب هي خيارات للتفرّغ لفضاء الكتابة، بمعنى التفرّغ للنشاط الثقافي، لكوكبة من الأنشطة التي تدور في فلك الكتابة بدون أن تكون كتابة بالضرورة.
حين بدأتُ الاستكتاب لمواقع وصحف عربية سنة 2012، كانت بعض وسائل الإعلام تدفع 200 أو 400 دولار مقابل مقالات من النوع التي يكتبها أديب أو روائي، بمعنى المقالات “غير الصحفية” إن جاز التعبير، وخلال عدة سنوات بدأت هذه الأرقام بالانخفاض، حتى وصلت إلى 50 دولار في بعض الحالات، إلى جانب انتقال الكثير من المواقع إلى عدم دفع تعويض مادّي مقابل المقالات أصلاً.
هذا التهاوي في أجور الاستكتاب يجعل الكاتب أمام خيارين؛ إما التحوّل إلى “مطحنة” مقالات، وتحويل المقالات التي يكتبها من مساهمة في الحوار من موقعه كمبدع إلى مجرّد سلعة عليه أن ينتج منها ما يكفي لسد رمقه، شأنه شأن أي عامل أو موظف لديه حد أدنى من الإنتاج عليه تحقيقه، أو الانتقال للعمل بدوام كامل في الوظيفة الثقافية أياً كانت، وبالتالي عدم التفرغ للكتابة بشكل أو بآخر.
إذاً فإن جميع الكتاب العرب – خصوصاً المقيمين داخل الدول العربية – محكومون بأن يكونوا كتاب يوم الأحد، محكومون بأن تكون الكتابة نشاطاً جانبياً في حياتهم، كمّياً على الأقل. فلنتخيل أن أمير تاج السر يمتلك ثماني أو عشر ساعات إضافية كل يوم، أي أن يكون لديه مثلاً ضعف الوقت الذي كان لديه للكتابة، بما للكتابة من تفرّعات من قراءة وأبحاث وأسفار وغيرها، هل سيكون منتجه الأدبي نفسه؟ هل سيكون بنفس الحجم ونفس الجودة؟
أين النقود؟
على الرغم من قلة الكتب العربية المنشورة سنوياً مقارنة بالعديد من اللغات واسعة الانتشار الأخرى، كالإنجليزية والفرنسية والصينية، فإن ذلك لا ينعكس حصة أكبر من العائدات بالنسبة للكتّاب، والسبب ببساطة أن الكعكة التي يتم تقاسمها أصغر بكثير من تلك التي يتقاسمها الكتاب باللغات الأخرى.
ليس الأمر متعلقاً بأزمة قراءة، فالعرب – أو كثيرون منهم على الأقل – يقرؤون، والإقبال الواسع على معارض الكتاب في شتى المدن العربية يوحي بأن القول بعكس ذلك يجافي الواقع. إنما الأزمة هي أزمة إنفاق على القراءة، فالعربي نادراً ما ينفق على الكتب بشكل دوري، ولنكون أكثر إنصافاً فإن العبارة الأدق هي “نادراً ما يستطيع أن ينفق”.
في الدول العربية التي تشهد تدهوراً اقتصادياً ينعكس على سعر عملاتها، باتت أسعار الكتب أرقاماً خيالية بالنسبة لمعظم قاطنيها، فالكتاب الذي يبلغ سعره ثمانية دولارات مثلاً، يبلغ سعره في سوريا حوالي 100 ألف ليرة سورية، رقم تستطيع قلة قليلة التخلي عنه في سبيل “رفاهية” مثل القراءة. وحتى الكتب التي تستطيع تحقيق انتشار واسع، فإنها محكومة بالتحول إلى نسخة إلكترونية مقرصنة، وبالتالي عدم انعكاس انتشارها عائدات على دار النشر أو الكاتب.
ولا يمكن بطبيعة الحال إلقاء اللائمة على القرّاء محدودي الدخل لقراءتهم الكتب المقرصنة أو المنسوخة أو عدم المساهمة في التعويض المادي للكاتب والناشر بأي شكل من الأشكال. ولكن هناك طرف ثالث من المعادلة لا يمكن تجاهله. ففي حين تحجب الحكومات العربية ما هب ودب من المواقع الإخبارية والمدونات والمواقع الإيباحية، فإننا لا نسمع بحجب موقعٍ يتيح الكتب المقرصنة إلا ما ندر – أنا شخصياً لم يسبق لي أن سمعتُ بذلك.
وحتى إن تم إيقاف موقعٍ إلكتروني عن العمل لتوفيره كتب مقرصنة، فإن ذلك غالباً ما يحصل بفضل جهة أجنبية، مثل مقدم خدمات استضافة الموقع الإلكتروني أو جهات إنفاذ القانون في الدول الغربية، وحتى على الأرصفة التي يفترض بأنها في متناول يد الحكومات، تنتشر الكتب الورقية المزوّرة بلا استحياء، وهي أزمة يمكن لأي ناشر أن يحدّثك عن آثارها الكارثية لساعات، خصوصاً في مصر وسوريا.
وحتى الناشرين ليسوا معفيين تماماً من اللائمة، فمثلاً إزالة المواقع الإلكترونية التي تنشر الكتب المقرصنة تتطلب من حيث المبدأ أن يتقدم أحدٌ ما بالشكوى، وفي حين تعلو أصوات الناشرين عند الحديث للصحافة وعلى صفحات شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص قرصنة أعمالها وحرمان دور النشر والمؤلفين من عائدات عملهم، فإننا لا نرى أو نسمع بأي خطواتٍ عملية يتم اتخاذها لإخماد جبهة واحدة على الأقل من جبهات نهب سوق الكتب، منتظرين أن تتحرّك الحكومات لإيجاد حلٍّ جذري لمشكلة هي أولاً مجرّد عرض لمشاكل أعمق، وثانياً هي مشكلة أصلاً لا يصب حلها في صالح هذه الحكومات، بدون استطراد يُخرجنا عن موضوعنا.
خبر سيئ وخبر سار
قد ينجو بعض الكتاب من خط الفقر بفضل أي شيءٍ سوى الكتابة نفسها، وربما تستطيع قلة قليلة من الكتاب – مؤلفي الكتب الجذابة الصالحة لرفوف السوبرماركتات غالباً – أن تتعدى خط الفقر وتدخل نعيم التفرغ للكتابة.
ولكن بالنسبة للغالبية العظمى، فإن هناك خبران أحدهما سيئ والآخر سار. الخبر السيئ هو أن عمق أزمات مجتمعاتنا ومنظوماتنا لا يبشّر بحلّ أو تحلحل قريب، وغالباً سيموت معظم الكتاب الأحياء اليوم بدون أن يروا اختلافاً جذرياً في الجدوى المادية لفعل هناك خلاف على أنواع الجدوى الأخرى لممارستة.
أما الخبر الجيّد فهو أن ذلك لن يمنع معظم هؤلاء الكتاب من مواصلة الكتابة، وستظل الكتب العربية تخرج أفواجاً كل عام من مختلف دور النشر، وبينها العديد من الدرر التي سنكون ممتنين بفضلها لأي كان من يقيم أود مؤلفيها، ويتيح لهم ساعة أو ساعتين كل يوم للكتابة، إلى جانب يوم الجمعة أو الأحد.