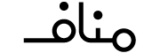حملت مسدساً للمرة الأولى والأخيرة في حياتي عندما كان عمري ست سنوات، كنتُ في منزل صديقٍ جديد لي والده ضابط في الجيش، أخدنا المسدس من خزانة والده، واستعرض صديقي كيف يقوم بتلقيمه، كان خالياً من الرصاص، علمتُ ذلك بعد أن وجهه إلى رأسي وضغط الزناد، الآن أتذكر أننا لم نتأكد من ذلك قبل تصويبه لرأسي، في المدرسة نفسها كنا ممنوعين من اللعب بـ”الدحاحل”، ولكن لعبة “حرب” لم تكن ممنوعة، اللعبة كانت عبارة عن الشعبة الأولى من الصف الخامس (شعبتي) تقف وظهرها للحائط، وتهجم شعبة أخرى علينا ونبدأ بالضرب، كل أساليب الضرب مسموحة مادامت الحجارة والأسلحة غير مستخدمة، كنتُ أتفرج على صديقي صغير الجسد يُرمى في الهواء ليسقط على أرضية الباحة الاسمنتية.
أتذكر مرة كان أحد الطلاب متهماً بلعب الدحاحل، فخُلع حذاؤه أمام المدرسة كلها، لتسقط من جوربه المثقوب الدحاحل المخبأة، ثبتَ على كرسيٍّ من قبل طالبين من أعوان الإدارة القذرين المعروفين باسم “الانضباط”، وبدأت المعلمة بضربه على قدميه بعصىً خشبية غليظة، الطفل كان يصرخ ويبكي ويترجى المعلمة أن تتوقف ولكنها ترفض، نفس المعلمة التي استفزتها رؤيتي لها وأنا في عمر الثامنة بلا حجاب، لم يكن ذلك العنف هو الوحيد من نوعه في مدرستي، فهذه المدرسة التي انتقلت إليها عند انتقال سكني، استقبلتني بصفعة على وجهي لأني توقفتُ للحظة أتأمل البناء الجديد عليّ من الخارج قبل أن أدخل، اليوم بدءاً من هذه التفاصيل، أجد نفسي – للأسف – أقل استغراباً من كم العنف الذي خرج من حيث لا ندري في سوريا.
منذ نبدأ بتعلم القراءة يبدأ تمجيد العنف، في حين كانت مدرستي مليئة باللوحات ومجلات الحائط التي تمجد الشهداء والضباط الكبار في تاريخ سوريا أمثال يوسف العظمة وعدنان المالكي، فإنني لم أعرف اسم عالمٍ واحد حتى انتهاء المرحلة الابتدائية، عدا اسم ابن سينا من شركة الأدوية، المنظمتين اللتين كانتا بمثابة نقابة لي في المدرسة تحملان أسماءً غريبة، وشعاراتٍ أغرب، طلائع البعث، خطر لي أن أبحث عن معنى كلمة “طلائع” حين سمعتُ نتيجة مباراة في الدوري المصري يحمل أحد فريقيها اسم “طلائع الجيش”، وفقاً للمعجم المدرسي (1985) معناها “طليعة الجيش: مقدمته ومن يبعث أمامه ليعرف خبر العدو”، نخرج من هذه “الطلائع” لننضم إلى “شبيبة الثورة”، المنظمة التي تضم طلاب سوريا في المرحلتين الإعدادية والثانوية حينها (بين عمري 13 – 18)، والتي أثناء مشاركتي في بعض أنشطتها لم أذكر تفاخرها بعبقري واحد، إنما مشاركتها في الكفاح المسلح ضد تنظيم الأخوان المسلمين، انتقلتُ إلى الجامعة، وفي كلية الإعلام لم تطلب مني أي مزاولة أو تدريب في العطلة الصيفية، فقط المشاركة في معسكر التدريب الجامعي، والذي يتضمن تدريباً على استخدام الأسلحة والمناورة على أرض المعركة، لم يكن التدريب الأول على السلاح، في الصف الثامن كافأني مدرب الفتوة بدرجتين إضافيتين لأنني تمكنتُ من إصابة علبة كبريتٍ ببندقية صيدٍ مرتين، بالطبع لا بد من التذكير بالملابس العسكرية التي كانت مفروضة في المدارس، والنظام العسكري الذي تدربتُ عليه لثلاث سنوات، ونجوت في الثانوية منه، ولكن كان عليّ للحصول على الحق في التقدم للشهادة الإعدادية أن أؤكد لمجموعة من أصحاب الثياب العسكرية أنني قادرٌ على تمييز الرتب وأنني مدركٌ أن “قوة الجيش في نظامه” وأنني يجب أن أنفذ ثم أعترض.
النظام التعليمي في سوريا لا يخبرك شيئاً عن نظرية التطور مثلاً، ولولا الإنترنت لكنتُ لم أسمع بها حتى اليوم، ولكنه يدرسك الفرق بين الكلاشينكوف والبندقية التشيكية، وكيفية تركيب الحربة على البندقية، وأي الأسلحة فيها قاذف رمانات، لقد تعلمتُ كيفية استخدام النابالم قبل أن أتعلم كيفية تخثر الدم، وتعلمتُ كيف أقتل إنساناً ببندقية خالية من الرصاص ولم أتعلم حتى الآن كيف أجري تنفساً اصطناعياً، فلنبتعد قليلاً عن وزارة التربية.
عندما بدأ الغزو الصهيوني على لبنان في تموز 2006 أول ما خطر لي هو صديقة لبنانية وعائلتها في بيروت، وكنتُ أحاول أن أسمع رنين هاتفها بسبب ضجيج أتباع “حمل الله” من حولي في مخيمٍ لحركة الشبيبة الأورثوذكسية يغنون “بالكاتيوشا بترجعوا، برعد تنين بتركعوا”، على شاشات التلفاز حين عدتُ إلى دمشق كانت القنوات تنقل الاحتفالات بشهادة جنودٍ مدججين بالأسلحة من حزب الله على عكس المدنيين العاجزين عن حماية نفسهم من بربرية الطيران الحربي الصهيوني، ولا أذكر حتى اليوم أي حديثٍ أو تقديرٍ لشجاعة مسعفي الصليب الأحمر اللبناني الذي كانت سياراته تنطلق كالريح على مرأىً من الطيران الصهيوني، وأيٌ من المراهقين في سوريا لم يكن متحمساً لمفاوضات السلام مع الكيان الصهيوني في تركيا كما انتظر بفارغ الصبر اشتعال فتيل الحرب معه كي يحمل السلاح وينطلق.
بدلَ أن يقود نضالنا ضد الاحتلال مفكرون كبار – أياً كان رأينا بمواقفهم السياسية مما يحصل في سوريا اليوم – من صحفيين وباحثين وعلماء وكتاب، كان عليهم أن يكونوا في الصف الثاني ليمجدوا أصحاب القوة التي لا يبدو أنها حتى اليوم حققتْ تقدماً يذكر سوى إصابة بعض صحارى الأرض المحتلة بصواريخٍ محلية الصنع، ورغم ثبات خطأ القاعدة على مر التاريخ، فقد حشي في رؤوسنا منذ تعلمنا القراءة والكتابة أن “ما يؤخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة”.
من السهل ربما أن نلوم الأطراف الإقليمية والدولية على تصاعد وتيرة العنف في سوريا، ولكن يجب ألا ننسى أن مئات الآلاف من الشباب السوري الذين انضموا طوعاً لقوات الدفاع الوطني والجيش الحر وكتائب الجبهة الإسلامية وغيرها ليسوا أجانباً وليسوا غرباء، وهؤلاء مثلي كانوا في أكاديميات العنف هذه، لقد أنشئنا على أن العنف هو الحل، على أن السلاح يحل كل المشاكل، لقد قضى أي شابٍ أكثر من عشرين عاماً محاطاً بخطابٍ سياسي ونظامٍ تعليمي ومضامين إعلامية وحتى منتج أدبي كلها تمجد العنف وتحرض عليه، تصف أي متحدثٍ بالسلام كحلٍ للصراعات التي مزقت المنطقة العربية بالخائن، تعم الاحتفالات بعيد الجيش وحرب تشرين أكثر من الاحتفال بيوم اللغة العربية رغم الجرعة العروبية الزائدة التي نتلقاها، أو بعيد الأم أو عيد المعلم، في سوريا يكاد يكون التدريس من أقل المهن أجراً وميزات، على عكس الضباط وأصحاب أدنى الرتب في أجهزة المخابرات، وخطاب الاستهزاء السائد اليوم بمؤتمرٍ هو الأمل الأخير لإنقاذ البلاد من دوامة العنف مؤشرٌ لا بد من ملاحظته، وخصوصاً رفض الكثير من وسائل الإعلام السورية (الموالية والمعارضة) استخدام مصطلح “مفاوضات السلام” في وصف ما يجري من جنيف، لما تحمله هذه الكلمة من اقتران بكلمة “خيانة” في رؤوسنا، قبل أن تسأل وتستغرب كل هذا العنف، عد إلى طفولتك، مراهقتك، تذكر التربية التي قدمتها لكَ مدارسك ومؤسساتك الدينية ووسائل إعلامكَ وسياسييك المفضلين وعائلتكَ على الأغلب، ببعض الموضوعية لن يكون السؤال “أين كان مخبئاً كل هذا العنف؟”، بل سيكون “من أين أتى بعض السلمية هذا؟”.