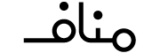هذه القصة كتبت في العام 2007، كانت من أولى محاولاتي القصصية، لسببٍ ما اخترت هذا الموضوع ليكون قصتي الأولى في مجموعة الفزاعة، رأيت فيما بعد أن مستواها الأدبي أقل من أن تنشر، وهكذا بقيت على حاسوبي لأكثر من خمس سنوات، ولكن اليوم بالذات حصل ما يجعلني مجبراً على نشرها، فقط كي أذكر الجميع وأولهم أنا من هي الفزاعة التي أقف بوجهها، كي أكف عن عصبيتي التي جعلتني مؤخراً أجد صعوبة في تقبل الآخر، سأكون صريحاً، لن تكون قصة ممتعة، وستجدون الكثير من الأخطاء اللغوية والتي لم أرد تعديلها كي تبقى بالضبط كما كتبتها في ذلك الحين، ولن أضع صورة كي لا يصل منها شيئٌ من الخيال لم أكن أنويه، استمتعوا….
لقد افتقدنا
حين يرحل الألم، لا يبقى لنا من الحياة شيئاً، لا يبقى لنا من الألم شيئاً، ونرحل نحن بعد الألم، نرحل دون الألم، فالألم لا يرحل، نحن من نرحل عن الألم. هناك اختبأنا سوياً أنا وأنتِ في حجرة مظلمة تذكرني بالألم، في مكان ضيق يذكرني بالألم، دخلتِ حينها مرتجفة، وأنا كنتُ أرتجفُ، منذ بداية التكوين الحبّ يرتجفُ في قلوب العرب، وهذه المرّة كنا نحن من يرتجف، وللمرة الأولى لم يكن الحب يرتجف فينا.
كم من الليالي مكثنا في زوايا مظلمة، وحاراتٍ معزولةٍ والأبواب لم تكن تغلق علينا، لم تكن هناك أبوابٌ أصلاً حينها، اليوم هناك أبواب، الحبّ لا يصبح حقيقة إلا خلف الأبواب أو أمامها.
جميلة عينيكِ، جميلة شفاهكِ، كل ما في وجهكِ جميل، أنفكِ … لا أدري بعد إن كان حقيقياً أم بلاستيكيّاً ولكنه جميل، وليس أهم عندي من جماله، وجنتيكِ متوردتان، لا أدري إن كان هذا لونهما أم أنكِ دائماً خجولة حين تريني، لا يغادر الخجل وجنتيكِ، سنتين والحب يتقاذف أرواحنا ولا زال الخجل لا يغادر وجنتيكِ.
كانت ترتسم أمامي صورتكِ، جمالكِ كان أسطورة تتحوّلُ لحقيقة.. لواقع أمامي، خلعتِ معطفكِ، فنحن الآن في غرفةٍ دافئة كدفءِ وطننا، وبرد الغربة في الخارج بات بعيداً عنا، ساعة من المطار إلى الفندق كانت كافية لتشعرنا بالغربة، لا نسمع شيئاً سوى أحاديثاً بالفرنسيّة، ولا شيء في الأجواء سوى أعلامٌ بيضاء وحمراء، ساعة من الغربة كانت، ساعة من البرد.
حين دخلنا تلك الغرفة عدنا إلى الوطن، عدنا إلى دفءِ الوطن، كان كلٌ منا يرى وطنه أمامه.
اقتربتُ منكِ تلامستْ أجسادنا، وتسللت من الجانب الأيدي لتلتقي، جبينكِ عانق جبيني، جبينكِ الآن عالقٌ بجبيني.
علاقة الجسد هي علاقة من الغيرة، كل جزءٍ من جسدنا يتحرّكِ بإشارةٍ من الغيرة، الشفاه شعرتْ بالغيرة من الجباه، اقتربت الشفاه، تلاصقتْ، تعانقتْ، اتحدتْ بمباركةٍ من أورنينا.
أجمل شيءٍ قد يمرّ في حياة الإنسان قبلة، أروع تجربةٍ في حياة كل إنسان قبلة، حين أقبلكِ أنفصل عن الدنيا، وتنفصل الدنيا عن إدراكي، كل شيءٍ في الدنيا ينفصل، ولا تبقى وحدة سوى بين شفاهنا.
أرجعتكِ إلى الخلف فجأة، وأخذتُ أخلع عنكِ ذلك القناع، ذلك القناع الذي يملأ بلادنا. هو ليس كباقي الأقنعة، فالأقنعة عادة تغطي الوجوه، أمّا هذا القناع فيغطي كلّ شيءٍ سوى وجه المرأة، قوة إلهيّة كانتْ تقودني، كانت يدي تحرّكها الآلهة، كانتْ تلك المرّة الأولى التي أخلع فيها قناعاً عن “وجه” امرأة عربيّة، على الرغم من ذلك كنتُ أتنبأ بمكان الدبابيس، وبطريقة خلع ذاك القناع.
بلحظاتٍ ارتسمتِ أمامي تحفة فينيقيّة أو تمثالاً رومانياً، كنتِ أمامي كما كنتِ دائماً، دائماً كنتِ بلا تمثيل بلا تصنع أو ابتكار واختلاق للعواطف، دائماً كنتِ عارية النفس أمامي، هذه المرّة كنتِ عارية الجسد، ولكن الاختلاف لم يكن شاسعاً.
نسينا ….
تكاد تكون أجمل كلمةٍ عربيّة، بأجمل صورةٍ ومتصلة بأجمل الضمائر على الإطلاق، حين يشترك شخصٌ مع أعز الناس إليه في استثمار أهم نِعم الآلهةِ علينا، سوياً ننفصل عن اللون الأسود الذي يُزرع في قلوبنا وعقولنا وحيواتنا منذ أن نولد.
نسينا أهلكِ ونسينا أهلي، نسينا ألمكِ ونسينا ألمي، نسينا الكدمات التي ارتسمت منذ ثلاثة أشهرٍ على الجسد الذي التهمه الآن، التي رسمها ذلك المخلوق الحي الذي يدعي أن يكون أحد البشر ويدعي الأبوة.
نسينا عشيرتي ونسينا عشيرتكِ، في ذلك الوطن الجريح لا يوجد أديانٌ، لا طوائف لا مذاهب ولا أحزاب سياسيّة، بل يوجد عشائر، عشائر ولاشيء سوى العشائر.
تركتكِ نائمة على ذاك السرير، ارتديتُ ملابسي وخرجتُ من الغرفة، لم أعلم أين أرحل ولكنني كنتُ أعلم أن شيئاً ينتظرني في تلك المدينة، ذهبتُ إلى موظف الاستقبال وطلبتُ منه بالانكليزيّة :
– هل لك أن تكتب لي عنوان الفندق على ورقة من فضلكَ؟
نظر لي شزراً، لم يعجبه أن أكلمه بالإنكليزيّة في مدينة تهرب من سلطة الذين يتحدثون بالانكليزيّة، أجابني بكلمة فرنسيّة متأكداً أنني سأفهم:
– نعم ….
كتب العنوان وأعطاني إياه، لم أحاول قراءته، كل ما كان يهمني منه أن أعطي الورقة لسائق التاكسي حين أقرر العودة.
أسير وحيداً، أرتجف من البرد، كنتُ أفكر أن أدخل إلى مكان عام بين الفينة والأخرى لأتدفأ، ولكن تلك ليلة الميلاد، والازدحام سيدّعي إجراءاتٍ أمنيّة، وعربيٌ مثلي على الرغم من الطوق على رقبتي لن يكون مرحباً به، وفيما كنتُ أسير لمحتُ حروفاً تذكرني بالوطن، كتاباتٍ فرنسيّة تحمل اسماً ينتمي للعروبة
L’Eglise De Saint Georges
ذلك القديس هو ملكٌ لسورية، وليس مُلكاً أو شفيعاً لأحد إلا لسورية، رغم أنني أعلم أنه معروفٌ في كل حي مسيحي في العالم، إلا أن شيئاً ما أغراني بالدخول، شعرتُ بالوطن يستنجد بي من الداخل.
حين وصلتُ إلى عتبة الكنيسة ترددتُ في الدخول، خشيتُ ألا أكون مرحّباً بي هنا كما كنتُ في سورية، لحسن حظ المسيحي في سورية أنه ما من قانون يسمح للرجال سود اللباس بمنع مسيحي من الدخول إلى الكنيسة، لكن ليس هناك قانون يمنع المصلين من رمق المخطئ – كما يحكمون عليه – بنظرات الاحتقار.
هنا أنا غريبٌ، أحدٌ لا يعرفني، وأحدٌ هنا لن يرمقني بنظرة احتقار، وربما حتى لو علموا قد يكونون بحكم البعد عن الفزاعة مدركين أخيراً أن الحق الطبيعي لأي إنسان حين يجد شريكة روحه أن يرتبط بها برباط مقدس، لا تقديس كنيسة ولا تقديس عمامات، بل تقديس إنسان …
دستُ بقدمي على مخاوفي، ودخلتُ ذلك المكان المقدس قدسيّة شخصيّة خاصة بي قبل أن يكون مقدّساً تقديساً إلهياً.
كانت ليلة الميلاد، والكنيسة كانت كنيسة عربيّة للروم الأورثوذوكس، كانت مرنمة ترنم منفردة…. ” لقد افتقدنا مخلصنا”
أنا بعيدٌ عن الفزاعة، مع التي أحب، أشاركها السرير، ولا أحد يبالي هنا أن إحدانا ترتدي حجاباً والآخر يرتدي صليباً في عنقه، والأمر الوحيد الذي أستطيع أن أصدقه هو أن المخلص الآن قد افتقدنا وليس منذ ألفي سنة.