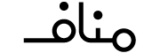منذ غادرت سوريا تقريباً وأنا عاجز عن الكتابة، قضيتُ أسابيعي القليلة في لبنان مع المرض وحاسوب معطل، وطوال الشهور الأولى لي في دبي أطبق التوتر والضغط النفسي على صدري أكثر من أن أستطيع الكتابة أو التفرغ وترك كل شيءٍ لأكتب فكرة ستنتهي في القمامة كما كنتُ أفعل في دمشق.
اليوم أعيش أسلوب حياةٍ مغاير تماماً لما اعتدتُ عليه، ساعات العمل اليومية الطويلة، والطرقات المزدحمة فيما أذهب لعملي وأعود منه في نفس توقيت معظم العمال المكتبيين في دبي. ليس أسلوباً جديداً علي، فقدت عشته منذ منتصف 2009 وحتى منتصف 2011 تقريباً، وكنتُ من النوع الذي أستغربه اليوم من الموظفين؛ الذين يقضون نهارهم بالكامل في المكتب. حين كنتُ في سنتي الثانية والعشرين، كنتُ أعمل في موقع إخباري كمحرر ومراسل، وفي الوقت نفسه أدرس لسنة التخرج في كلية الإعلام بجامعة دمشق، إضافة لعلاقة عاطفية كانت تستهلك ما يتبقى من وقتي، ومع هذا الجدول المزدحم لم أكن أمانع أحياناً البقاء في مكتبي حتى منتصف الليل أو أكثر ما دمتُ أملك ما يكفي من السجائر وقادراً على الحصول على وجبة خفيفة حين أحتاجها.
بدءاً من منتصف 2011، انتقلتُ للعمل الحر معظم الأحيان، وحتى في الفترة التي أكنتُ أدير فيها تحرير مجلة الحياة الجديدة، لم يكن لدي ساعات عمل يومية محددة ولم لدينا مكتبٌ ننتصب فيه كشجرة، بل أكنتُ أتجول في مختلف أنحاء دمشق وحاسوبي على ظهري، ألتقي بصحفيين هنا وهناك، أعمل من منزلي – الذي فقد الاتصال بالإنترنت بسبب ظروف الحرب بعد الأشهر الأولى من بدء العمل على المجلة – أو من مقهى أو من مقهى إنترنت أو من منازل أصدقائي، منذ منتصف 2011 وحتى منتصف 2018 لم أضطر إلا لأيامٍ قليلة أثناء السنة الأولى من الماجستير وربما عند تسيير بعض الأوراق الرسمية للاستيقاظ باكراً، مع تعرفي على مواعيد الازدحام الخانق في دمشق – بشكل مضاعف بسبب الحواجز الأمنية وتقلص المدينة – بتُ أضبط مواعيدي على الهرب من الطرقات المغلقة والجموع الكبيرة.
سبع سنواتٍ كاملة بالكاد استخدمتُ منبهاً أو اضطررتُ للكفاح من أجل مقعدٍ في حافلة أو سيارة أجرة.
الآن كل شيءٍ مختلف تماماً، من المعروف في دولة الإمارات أن معظم العطل الرسمية تأتي في النصف الثاني من العام، النصف الذي بدأتُ فيه العمل مع شركة أوجيلفي، لذلك كل ما مرت عدة أسابيع كانت تأتي عطلة ليوم أو يومين تعطيني فرصة لالتقاط أنفاسي، خصوصاً بسبب العادة الجميلة في الإمارات التي تقضي بتغيير مواعيد العطل الرسمية بحيث تجعل من العطلة الأسبوعية أطول. رغم أنني حين بدأتُ هذا العمل توقعتُ أن أواجه مشكلة في الالتزام بساعات العمل الطويلة أو الاستيقاظ المبكر بدون مساعدة بشرية، فإنني الآن أسترجع هذه الشهور القليلة التي مرت وأستغرب من نفسي، لقد نجحتُ في عدم التغيب عن العمل سوى ليومٍ واحد فقط! بالكاد تأخرتُ عن العمل أكثر من 15 دقيقة منذ بدأت، وحتى إنني مؤخراً بدأتُ أشعر بأن عطلة ليومين في الأسبوع طويلة بعض الشيء.
وماذا عن الكتابة؟
لا بد من الاعتراف بأن الحياة فوضوية الزمن التي كنتُ أعيشها وما أتاحته لي من أريحية التحكم بوقتي ومواعيد نومي واستيقاظي كانت ممتازة للكتابة، أربع سنواتٍ كاملة أنفقتها في كتابة “ظلال الآخرين”، وبالتوازي كتبتُ كتاباً آخراً هو ما بين المذكرات والنصوص، وقد خرج هذا الكتاب في النهاية صادقاً وجميلاً إلى حدٍّ يجعلني ميالاً لعدم نشره.
ولكن الآن، حين أقرأ ما كتبته في تلك الفترة من النصوص والمذكرات وبعض مقاطع روايتي في تلك الفترة أتفهم لماذا معظم البشر لا يقرؤون، أو على الأقل لماذا لا يقرؤون للكتاب الكسولين الذي يستيقظون والشمس موشكة على الغروب. حين وصلتُ إلى دبي بدأت تدور في رأسي فكرة رواية قصيرة عن راقص يموت في ما يبدو أنه انتحار، وتدور أحداثها بحثاً عن جواب السؤال “هل انتحر هذا الراقص فعلاً؟”، كانت مقولتي في هذه الرواية التي أجهضت في رحم مخيلتي جاهزة: المجتمع البشري أقبح من أن تحتمله روح الفنان المرهفة. تحمستُ في أحد الأيام وكتبتُ الفصل الأول في جلسة واحدة على الورق، كتبتُه وشعرتُ أنني انعتقتُ أخيراً من سجن اللاكتابة الذي يخنقني منذ غادرتُ دمشق. الآن حين أفكر بأحداث وحبكة وشتى التفاصيل المرهقة التي ترافق كتابة أي رواية، أجدني أفقد حماستي لكتابتها شيئاً فشيئاً حتى ماتت.
قراءة الكتب لم تعد بالكثافة التي كانت عليها وكذلك التأمل المطول في الأفكار والأشياء.
زملائي في العمل ينظرون لي – بإيجابية أو سلبية – كمسخٍ أو كائن بدائي صفعته الحضارة البشرية في وجهه دفعة واحدة، إنكليزيتي التي تؤهلني لقراءة أعمال تشارلز ديكنز ودوغلاس أدامز لا تؤهلني لطلب الغداء بشكل ملائم أو السؤال عن نوع الخبز الذي أريد شراءه.
بالنسبة لي ما يحصل الآن هو قفزة طويلة نحو شيءٍ عظيم، الكتب التي كنتُ أقرؤها لأتعرف على الحياة والشعوب الأخرى بعيدة عني الآن، ولكن في المقابل أرى وألمس الحياة بلحمها وشحمها وأتعرف على الشعوب الأخرى شخصياً. في عملي هناك امرأة من جنوب أفريقيا، سألتها عن سيكستو رودريغز، تكلمت عنه بعينين لامعتين واصفة شعورها حين حضرت حفلته بعد أن كبرت على الاستماع لأغانيه، فيلم وثائقي كامل عن الرجل لم يستطع أن يوصل لي تلك العاطفة التي يشعر بها الأفريقيون الجنوبيون (الشقر في كثير من الأحيان) تجاهه.
الآن ما زلتُ عاجزٌ عن الكتابة، ولكنني في الوقت نفسه بدأتُ بالتخلص من لوثة السعي إلى النجاح المهني التي تحاصرني هنا كفأر عديم الحيلة، سأظل عاجزاً عن الكتابة لوقتٍ ليس بقليل، ولكن في الوقت نفسه سأعيش الحياة التي يعيشها مئات الملايين حول العالم، وعندها سأكون قادراً على مخاطبتهم، على لمس مشكلة تتجاوز ندرة القراء، وسأخرج برواية لن أندم يوماً على سطرٍ واحدٍ فيها.
ربما لم أعد أملك صباحاتي المعتادة المخصصة للكتابة فيما ينام الجميع، ولكن ما زلتُ أملك مغامرة طويلة ومملة يدعوها معظم البشر الحياة، مغامرة لا يمكنني أن أكتب ما يغير حياة الآخرين بدونها.