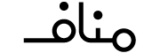لا بد من وجود مخرج، لا بد من أن أستطيع الهروب من هذا المكان المقزز الذي تركوني فيه، كل يوم يقولون لي أنني سأقضي فيه القليل من الوقت، ولكن هذا “القليل من الوقت” يمتد ليصبح أكثر من ست ساعات، لا بد من سببٍ ما يجعلهم قادرين على خطفي لكل ذلك الوقت، أمي أوصلتني لهنا، وبقيت تنتظرني في الخارج في سيارتها، أعلم أنها في الخارج، لا بد أن الوقت يهرب منها، لا تشعر بمرور الساعات الست كل يوم، لا بد أنها لا تعرف أنهم يستمرون بإزعاجي طوال الوقت بأغانيهم التافهة، ودروسهم التي لا أفهم منها شيئاً، ولا أفهم لماذا يدرسونني بكل الأحوال من الآن، لقد راقبت أختي الكبرى قبلاً، وعرفت أن كل ما يدرسوننا إياه في هذا المكان الغبي سندرسه من جديد في المدرسة، وسنكون حينها قادرين على التعلم أفضل من الآن.
الأمر بات يتكرر يومياً تقريباً، خمسة أيام أذهب ومن ثم ليومين لا أذهب، بعدها خمسة أيام أخرى أذهب ومن ثم يومين لا أذهب، ذات السيناريو كل مرة، أحياناً يضعون ورقة في الدفاتر التي في حقيبتي، وحين يكون هناك ورقة لا نذهب في اليوم التالي، عليّ أن أجد طريقة للخروج، لألاقي والدتي المسكينة التي تنتظرني في الخارج ولا تشعر بالوقت، كم هم أغبياء الكبار، رغم أنهم يعرفون قراءة الساعة على عكسنا ولكنهم لا يستطيعون معرفة كم مر من الوقت منذ تركوا طفلتهم مع هؤولاء الغرباء.
الأمر الذي يستفزني حقاً هو أن أمي لا تأتي سوى آخر أمهات الأطفال الآخرين، أولئك المعتوهين السعداء بهجر أهاليهم لهم، ورغم تأخرها بدلاً من الصراخ بهم لأنهم احتجزوني كل ذلك الوقت تقوم بالابتسام لهم، وتشكرهم، لا أصدق أنها تشكرهم، كل يوم تشكرهم، “يسلموا إيديكن”، جربت البكاء عدة مرات ولكن الأمر لم يكن يجدي نفعاً، كل ما كان يمنحني إياه هو التأخر لساعة قبل بدء احتجازي، أو خروجي من الاحتجاز قبل ساعة من الباقين، وحتى مع الوقت لم يعد البكاء يعطي أي نتيجة تذكر.
بدأت بمراقبة كل النواحي من حولي، باحة اللعب، الممرات، الصف، الجدران، الباب، كل شيءٍ… ولكن يبدو أن المكان مصمم كي يستطيع الكبار في الحجم الخروج بنفسهم فقط، فالصغار لا يستطيعون تسلق الجدران أبداً، الباب له مقبضان أحدهما مرتفع من شبه المستحيل أن تطاله يداي أو يدا أي طفلٍ من الموجودين هنا.
حين ندخل الصف فنحن شبه محتجزون بشكل نهائي، هناك سببان للخروج من الصف، الأول أن يكون علي الذهاب إلى الحمام، والثاني هي تلك الفترة القصيرة التي يتحننون علينا بها لنلعب فيها بألعابهم الغبية، حين أكون في ساحة اللعب لا يمكنني الهروب، فالشابات المسؤولات عن الأطفال يكن متوزعاتٍ حولنا كحرس الجيش، وحين يشعرن بأي منا يحاول الخروج إلى خارج نطاق نظرهن يجرين إلى عنده فوراً ويطلبن منه العودة إلى الداخل، واللطيف أنهن يطلبن منا العودة إلى السجن منادياتٍ أيانا بـ”حبيبي” و”حبيبتي”، لا أصدق كم الكبار قادرون على الكذب.
بقيت أكثر من ثلاث “خمسة أيامٍ” أراقب كل شيءٍ، أجرب الخروج إلى الحمام في أوقاتٍ مختلفة، لأعلم كيف تسير الأمور في ذلك المكان المقزز، توصلت إلى نتيجة جعلت هروبي وعودتي إلى أمي التي تنتظرني في السيارة بالخارج قاب قوسين أو أدنى، في حوالي الساعة ونصف الساعة الأولى من وصولي إلى المكان لا تكون هناك أي شابة في الملعب، والباب المؤدي إلى الملعب يكون ما يزال مفتوحاً من أجل الأطفال الآخرين الذين يأتون متأخرين، ولكن في الربع الساعة الأخيرة من هذه الساعة والنصف لا يأتي أطفالٌ إلا ما ندر، وتكون الشابتان اللتان تساعداننا بالدخول إلى الحمام مشغولتان بإعداد الطعام، والنشاط الوحيد الذي لا يراقبنا أحدٌ أثناءه هو الطريق من الصف إلى الحمام ومن الحمام إلى الصف.
جاء اليوم المنشود، كل ما علي فعله هو الخروج، ملاقاة والدتي في السيارة، تنبيهها إلى أنني في الداخل وأنها لم تنتبه إلى الوقت، وهكذا أتخلص من القدوم إلى هذا المكان إلى الأبد، أعود لقضاء الوقت مع أمي، مع أختي وأبي، النوم لساعة متأخرة كما يفترض بي أن أفعل ككل الأطفال المدللين، جاء اليوم..
أصبحت الساعة العاشرة، هذا هو الوقت المناسب بالذات، نهضت عن مقعدي، وضعت يدي بين ساقيّ ووقفتُ أمام الشابة التي كانت تكتب على كتب الأطفال الآخرين، ابتسمتْ لي ببلاهة وطلبت مني الذهاب بسرعة وأن أطلب من المربية أن تساعدني في الدخول إلى الحمام، ذهبتُ ووقفتُ أمامها، بالكاد استطاعت أن تجد وقتاً كي تساعدني في خلع بنطالي وغسل يديّ، تأكدتْ من خروجي وعادت لتجهز ما تبقى عليها من الطعام، أما الأخرى فرأيتها وأنا خارجة من الحمام تساعد أحد الصفوف على توزيع الطعام.
خرجتُ من البناء إلى باحة اللعب وكما توقعت لم يكن أحدٌ هناك، وصلتُ إلى الباب، وبقيت آخر خطوة قبل أن أتمكن من الخروج من هذا المكان الكريه، كان بقرب الباب هناك أحواض نبات، وقفتُ على إحداها حتى تمكنتُ من فتح المقبض العلوي وبنفس الوقت تمكنت من دفع السفلي بقدمي اليمنى، بعد أن فتح المقبضين سوياً قمت بدفع جسدي – ومعه الباب – بقدمي اليسرى إلى الوراء، أفلتُ الباب وعدتُ إلى الأرض.
خرجتُ، إنها الحرية، بتُ الآن حرة لأعود إلى حضن أمي، وقفتُ أمام باب ما عرفتُ لاحقاً أن اسمها روضة، ولكن… أمي ليست هنا، سيارتنا ليست هنا، ماذا؟ هل كانت تكذب علي؟ هل كانت تقول لي أنها في الخارج فقط كي تجبرني على البقاء؟ حسناً، لن أهتم، وإن كانت أمي ليست هنا كل ما علي فعله هو أن أذهب إلى المنزل، ولكن..
لا أعرف طريق المنزل، كيف فاتتني هذه النقطة؟ كل يوم كانت سيارتنا تأخذني وترجعني إلى هنا، كيف لم يخطر لي أن أحفظ الطريق بين هذين المكانين؟ خروجي لم يقدم لي أي فائدة، سيكون علي العودة إلى الداخل.. يا لخيبة الأمل.
وقفتُ أمام باب الروضة – الذي كان قد أغلق – وقرعتُ جرس الروضة الذي تركوه منخفضاً كي نتمكن من قرعه عند العودة من الهروب ربما، سأخبر من في الداخل ممن يفكرون بالهروب أيضاً أن أمهاتهم لسنَ في الخارج، وأننا إن لم نكن نعرف طريق العودة إلى المنزل فلا فائدة من الهروب، ولا فائدة من الحرية.