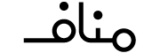ورقة سوداء.
لم أكن يوماً من محبّي الورق قراءة أو كتابة، قرأت ثلاثة أرباع كتبي على كيندل، لو اشتريتُ مكتبة الآن سيكون مظهرها مضحكاً لقلة الكتب التي فيها، ولكنني لا أكترث، أسير وفي جيبي مئة كتاب، من يمكنه أن يقول لا لهذا؟
هنا أكتب على صفائح تريحني، أحب أن أبدأ الكتابة دائماً على ورقة سوداء، وخلفية سوداء، أحب أن تكون الشاشة ليلة ظلماء أعكر صفاءها بعباراتي. هنا أكتب بكلتي يديّ، لا تتفرّج اليسرى على معركة طاحنة على الورق عاجزةً عن التدخل سوى لتثبيت الورقة التي تفترسها اليد اليمنى.
هنا أكتب برأسٍ مرفوع، وعند الكتابة على الورق أحني هامتي.
لو لم أتعلم استخدام الحاسوب، ما كنتُ كتبتُ الروايات. كل المسودّات والنسخ المتتالية لكل رواية تتحوّل إلى ورق؟ أين سأضع كل هذا الورق؟ أنّى لي عضلاتٍ مفتولة لحمل كل هذا الورق والحفاظ على ترتيبه؟ لو كانت رواياتي تكتب على ورق، ستضيع على الأغلب أو يُسكب عليها فنجان شاي قبل أن تصل لدار النشر.
الورق يصعب نقله، وحين لا تكون لدينا القدرة المالية ولا الزمن الكافي لنغادر مكاننا فجأة وبدون مقدمات، ما يصعب نقله يترك خلفنا ليلتهمه الزمن وأيدي اللصوص. في ساعات تقنين الكهرباء الطويلة كدتُ أفقد عقلي لولا الكيندل، لولا إضاءته الضعيفة التي تبقي أمسيتي على قيد الحياة، سواءً ككتاب أو مصباح كسول.
لم يعجبني الورق يوماً، رائحة الكتب لا تحرّك داخلي أي شعورٍ بالفرح، فقط تذكير بأن هذه الأوراق قادمة من منشأة صناعية ما، وما هي إلا نسخة عمّا خطّه الكاتب. يقول بطل “قلوب على الأسلاك” لعبد السلام العجيلي أنه لا يحب الاحتفاظ بالكتب، كي يحافظ على عادة قراءة كتب جديدة وأسباب أخرى لا أتذكرها، ويقوم بالتخلص من كتبه مانحاً إياها لمن يرغب متخلياً عن تشييد مكتبة في منزله. أعجبني تلك النظرية، وكنت للتو نصبتُ أول مكتبة منزلية في حياتي، لا يزيد عدد الكتب فيها عن 100 كتاب، ولكنني حين راقبتها عدة مرات متأملاً كل ما تشعله هذه العناوين المتربعة قرب بعضها من ذكريات، قلتُ لنفسي هذا يكفي… لستُ بحاجة لنصف هذه الكتب بكل الأحوال.
أنا أحب الكتب نفسها، تلك الروح التي تسكنها بمجرّد رصف الحروف والكلمات قرب بعضها بشكل ما، أنا أرى – كما يقول حنا مينة – أن على كل من يستطيع الكتابة أن يكتب كتاباً، فننجب الكتب كالأطفال وتتكاثر مالئة حياتنا. فليكتب كل منا ألف كتاب، أو مئة، أو عشرة، أو… كتاباً واحداً على الأقل.
داخلي طفل يكلّم السيد هيراوكا باكياً، أرجوكَ يا سيدي لا تقدم على هذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر، الناضحة برائحة الموت. دع السياسة لرجال السياسة وامكث هنا، واكتب مئة رواية أخرى، أو عشر روايات أو حتى رواية… واحدة… كيميتاكي سان. ولكنه لا يستمع، يرسل مخطوطه الأخير ويغادر رفقة أصحابه، يلقي خطاباً يشق فيه الجدار السميك الذي يفصل بين الروائي وجمهوره، ويغادر العالم بشرفٍ رفيع مسطّراً صفحة أخيرة لبحر خصبه.
وماذا عن الروايات؟ إنهم يموتون جميعاً وفي قلوبهم تمكث ألف رواية تترجّى القدر ليوم حياةٍ يكتبون فيه ولو صفحة واحدة. حين يرحلون، من يكتب الروايات؟ هل نستمع لأفواهٍ جديدة؟ ساعاتنا القليلة في هذه الحياة لا تكفي لقراءة كل هذه الروايات، فهل نقامر بها على أقلام غريبة؟ الروائيون يتكاثرون هذه الأيام، وجميع من يتحدّثون عن الكتب كاذبون ولا يعجبهم نصف ما يقرؤون، والبحث عن رواية دسمة في هذه الفوضى أمر متعب للأعصاب.
موتوا، كي نختبر طعم حلوقنا في الصباح ونقرر إن كنا سنمنحكم الخلود أم لا. ما دمتم أحياء لا نستطيع امتلاككم، أما الكتّاب الموتى فيمكثون هادئين تاركين لنا الاستماع لسطورهم بالأذن التي تريحنا، نسرق أصواتهم، نضع حناجرهم في كفوفنا كدمية رخيصة ونحرّكها: “المؤلف اختار كذا وكذا لأنه يريد أن يقول كذا وكذا”.
ونحن، الذين نتولى مهمّة حمقاء كالكتابة، نتوق إلى الموت، ليس الآن، ليس قريباً، لكن عندما نكون راضين عمّا كتبنا. نعرف أننا لن نحظى باختبار صادق لعملنا قبل موتنا؛ إنها بئر نرمي فيها القنابل والمعجنات الطازجة على أمل أن نغيّر شيئاً في قعرها الذي لا نراه.
*
أزور معارض الكتاب كطقس أكثر منه كوجهة تسوّق، أقتنص بعض الكتب، وأعيد نصفها إلى مكانه قبل المغادرة. أتفرّج على الكتب مرمية كجثث على أرفّ وبسطات دور النشر والمكتبات، معروضة بإذلال لأيدي العابثين الموسميين كما لو كانت في سوق نخاسة.
اشتركتُ في المكتبة العامة ولم أستعر منها بعد مرور عامٍ على اشتراكي كتاباً واحداً، لديهم الكثير من الكتب، وحين يتاح لي زمن للقراءة فهنالك من الخيارات ما يكفي لعمرين كاملين. عدتُ للكتب الورقية غير المقروءة لديّ منذ عدة أسابيع، وقرأتُ منها خمس كتب اكتشفتُ فيها واحداً واحداً أنني قرأته من قبل، ولم أتوقف عن القراءة بكل الأحوال.
القراءة تحتاج وقتاً طويلاً، والكتابة تحتاج عُمراً بأكمله، وبين هذا وذاك بالكاد هناك متسع أضيق من كس عقربة للعمل تسع ساعات كل يوم، خمسة أيام في الأسبوع. الكتب تطلب كل انتباهك واهتمامك، عليكَ أن تخلع وجهك وترتدي قناع الرواية كي تصلك لمحة عمّا ما ملأ رأس الكاتب ودفعه لكتابتها.
أنا لم أحلم يوماً بأكثر من غرفة هادئة ودافئة، مع ما يكفي من الطعام والموسيقى، كي أقرأ لأيام بلا منغصات. ولكن الحياة هنا – خارج الحروب – سريعة كسباق حواجز، ولديّ كل يوم واجبات لا تنتهي. زمني في هذا العالم يُستنزف، هذه المكاتب تمتص عُمري وتبصقه منهكاً متهالكاً. أسرق كل يوم ساعتين أو ساعة على الأقل أقضيها في الكتابة أو القراءة، أعمل كل يوم تسع ساعات وأهدر ساعة ونصف على الطريق وأنام لأجدد طاقتي ثماني ساعاتٍ، كي تتاح لي ساعة أو اثنتان تكونان ملكي أنا.
في هاتين الساعتين، لا تعنيني النقود بشيء، أنا هنا لألهو فقط. أنا هناك لأراقص السطور وأخرج بسيرك ينال تصفيقاً حادّاً، ولو كان مني. أنا هنا لألعب، قوقعة الكتّاب الموتى لا تعنيني، ولا أسجن نفسي في مشروب وسيجارة وأغنية رتيبة. أنا أسكن في الشوارع الحيّة، أعرف عجلة نهاراتكم، وعلى دروبكم السريعة أنقش ملاحظة أو اثنتين، أكتب فقرة أو اثنتين، وأعود لأرفع نظري وأبقيه على الدرب السريع.
الكتب الورق لا تلاحقني خارج المنزل، أما الكتب الأرواح فتلاحقني كجراء سعيدة، تتجوّل حول رأسي طول النهار. محاطاً بالوجوه الغريبة التي تراقب كتابي بفضول، أتحدّث مع الروايات، وأتلقى النصائح من القصص القصيرة، أجالس خيرة نساء ورجال الماضي، أصغي لهم يتحدثون بإسهاب عن حياتهم، عن خيالاتهم، عن العوالم التي بنوها في رؤوسهم وسكنوها، وينبهني أحدهم بشكل عابر لكون القطار قد وصل إلى محطتي.
حين كنتُ طفلاً بلحية يبحث عن معنى منطقي للحب، احتفظتُ بالذكريات الملموسة من كل فتاة تشغلني ولو لثانية؛ تذكرة السينما، زجاجة البيرة الفارغة، مئتين ليرة، غير قابلة للاستخدام بسبب اهترائها على أي حال. ولكن حين أحببتُ حقاً وانتهت رحلتي الاستكشافية، لم أعد أحتفظ بشيءٍ، وبات تركيز منصباً على الاحتفاظ بمن أحب. وهكذا هي علاقتي بالكتب التي نفذتُ إلى روحها وجالستُ شياطينها، أحب الاحتفاظ بها إلى الأبد، وليس أوراقها التي احتضنت لقاءاتنا الأولى.