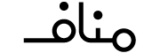دفاعاً عن نفسي أقول أنني لم أزر صفحتكِ على تويتر لغايات شخصية، دوافعي كانت – وأعترف بأمر مماثل للمرة الأولى في حياتي – سياسية.
دفاعاً عن نفسي أقول أنني لم أزر صفحتكِ على تويتر لغايات شخصية، دوافعي كانت – وأعترف بأمر مماثل للمرة الأولى في حياتي – سياسية.
ذلك الوجه الرمزي المستفز الذي تصرين على استخدامه، وإصراري المستفز على الاستمرار بمتابعتكِ، جعلا تغريدتكِ الأخيرة مستفزة إلى حدٍ كبير، كدتُ أرد عليها طارحاً السؤال حول توقيت إعادة نبش قبور الأحقاد القديمة الآن، ولكنني تذكرتُ أنني عديم المعرفة بآخر صرعات الاحتجاج والمطالبة، أذهب إلى صفحتكِ لأتأكد أن الأمر غير مرتبطٍ بموضوعٍ آخر أسبب لنفسي الإحراج بجهلي به، أدحرج صفحتكِ قليلاً، متذكراً أن بعضاً مما تنشرينه هنا بالذات حتماً بعضٌ مما ترغبين أن أرى أو أقرأ أو… أتذكر. تمر سريعاً صورة كلماتٍ عربية على جدار عاري الطلاء، وبعد تجاوزه بثوانٍ يجذبني الاسم المستعار المضاف إلى زاوية الجدار مصدراً للاقتباس، يصعد بصري إلى الكلمات نفسها وتبدو مألوفة إلى حدٍ لا يطاق، وكأنها… وكأني… أنا من كتبها، أبحث في حاسوبي عن كلمتين أو ثلاث منها، والنتيجة الأولى المكان الذي أحتفظ فيها برسائلي الأخيرة إليكِ، إنها كلماتي، سُلبتْ مني، جردتِني من كلماتي قبل أن أطلقها، العاقبة الأخلاقية عاهرة سافلة، في ذات اليومين، المجموعة التي تزودني بمعظم الكتب الإلكترونية المقرصنة التي أقرأ تقوم بقرصنة كتابي، ثم تشهرين في وجهي سلاح النشر الذي كنتُ أحتفظ به لأدفع الموت بعيداً عما تبقى من حكايتنا المفتتة أصلاً.
اليوم بالذات لم تمر ببالي فكرةٌ واحدةٌ عنكِ، كان نهاراً للذاكرة، الرسائل التي يرسلها الآخرون اليوم للتهنئة بعيد الفصح جعلتْ أسماءً كثيرة تقفز إلى سطح ذاكرتي، بعضهم يبعدون أربع قارات وبعضهم يبعدون مسير ثلاث دقائق واستدراك سنينٌ ينهكني مجرد التفكير بها، ولكن أنتِ… ولا حتى فكرة واحدة، ولا حتى اسمكِ أو دلالةٌ عابرة على وجودكِ في مكانٍ ما من هذا الكوكب، لتُسكبي في نهاية النهار عليّ كزيتٍ ساخن وأغرق في شعور الفقد الذي أتذكره الآن دفعةً واحدة.
لا أستطيع تذكر أي شعورٍ آخر بخصوصكِ على الإطلاق، محبة إجبارية تشغل زاوية واحدة والكثير من الفقد. غرقتُ اليوم في بعض القراءة عن اللغات السامية، والآن أتحرق شوقاً لأعرف أي هزائم و فراقاتٍ طويلة وعذابات جعلت كل هؤلاء الساميين يختزلون الفقد في هذه الحروف الثلاث، إن سكنْتِ آخرها تختنقين بالحرف الأخير. وهائنذا أردد الكلمة همساً أجرب وقعها على حنجرتي.