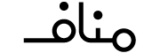من مجموعة (موت سرير رقم 12) لِـ غسان كنفاني (1936 – 1972) – مؤسسة الأبحاث العربية ش. م. م. 1961
من مجموعة (موت سرير رقم 12) لِـ غسان كنفاني (1936 – 1972) – مؤسسة الأبحاث العربية ش. م. م. 1961
في طريقي إلى المطعم كنت أشعر بأنني إنما أسير في عالم جديد، كل ما فيه جديد، الهواء والشمس والناس، ولم يكن الشارع الذي اعتدت أن أجتاز كل يوم في طريقي إلى المطعم شيئاً مألوفاً بعد، كان هو الآخر شيئاً جديداً، بدا لي كأنني أمشي فيه للمرة الأولى…
لو كنت أعرف أن الأمور سوف تنتهي على تلك الشاكلة، وبتلك البساطة، لأنهيتها منذ زمنٍ بعيد… لقد كانت، ثمة، كلمة واحدة وسقط الأمر كله عن كتفي، وأحسست بأنني انطلقت من نافذة كانت موصدة، وصرتُ مثل بقية الناس… كانت رئتاي قد اتسعتا، فجأة، وأصبح التنفس، مجرد التنفس، عملاً في غاية المتعة!
كيف حدث الأمر؟ يبدو لي الآن أنه حدث تحت دفع قوة قاهرة، ليست أنا، أو هي أنا في الواقع، ولكن دون خوف. لقد وقفتُ أمامه في مكتبه وكنت أعلم أنه إنما استدعاني ليعيد على مسامعي ما ردده أكثر من أربع مرات في الشهور الخمسة الفائتة:
– يا رياض… أنت تهمل عملك الحزبي بشكلٍ رهيب… خمسة شهور ورأسك في مكان آخر، كأنك لم تعد معنا… قلتها لك أربع مرات، وما زلتُ أؤجل الإنذار الأخير، لأنك خامة صالحة…
هكذا يتحدث دائماً، هكذا كان يتحدث، نفس الكلمات التي كانت تجعلني أرتجف أمامه: “بشكلٍ رهيب!” و”رأسك في مكان آخر” و”خامة صالحة” كل ذلك بدا لي ساعتها شيئاً متهافتاً كزجاج سيئ الصنع، ورغم ذلك فلقد كانت خيوط المطاط تشد لساني إلى الداخل، وكنتُ أدوّر منفضة السجائر على طاولته محتاراً…
– ماذا دهاك؟… هل تريد أن تترك الحزب؟
– نعم..
قلتها فجأة ودون أن أقدر على إيقافها أو طليها بدهان آخر، ولكن ما أن قفزتْ من شفتي حتى تقطعت خيوط المطاط، وانفتحت النافذة، ولم أعد أبالي… وحينما نظرتُ إليه كان قد صار رجلاً آخر، يقف هناك، لا يهمني، واحداً كالآخرين ليس له مقعد في رأسي أو على كتفيّ…
كلمة واحدة فقط، وسقط كل شيء فوق البلاط وتلاشى… وحينما صفقت الباب خلفي لم يكن ثمة ندم على الإطلاق… وكان الناس على الرصيف المقابل، يمشون مثلي، دون أن تكون ثمة أثقال على أكتافهم…
ثلاث سنوات وأنا أحمل قدراً كاملاً على كتفيّ… كأنني رجل ليس له في حياته من عمل سوى حمل ذلك القدر والمسير تحته على حصى وشوك، كأن الحياة، كلها، هي أن أكون حمالاً لحياة ليست لي… وكان الآخرون، طوال تلك السنين الثلاث يعيشون حياة لهم، ليس ثمة أثقال على أكتافهم، مجرد الحياة، دون ذلك الارتباط الغبي الثقيل… لماذا لم أختر الحياة مثلما اختاروها؟ هذا السؤال لم أفكر به قط… لقد نما في جوفي دون أن أحس به، وحينما أصبح ناضجاً، سقط عن شفتي بارداً:
– هل تريد أن تترك الحزب؟
– نعم..
وهأنذا خارج النافذة، مثل البقية، مثل الآلاف الذين شاهدتهم في الشارع يمشون على الرصيف المقابل، ذاهبين، وآيبين، سيان… دون أي حزنٍ، دون أي ندم… غمرة، فقط، من ضباب بلا لون… وحينما وقفتُ أمام واجهة تعرض أربطة عنق ملونة، مر سؤال في رأسي: “ترى هل أنا سعيد لمجرد أني تخلصت… أم لأنني تخلصت بسهولة، وبلا ندم؟” كانت أربطة عنق ملونة فاخرة، وكان السؤال سخيفاً ولا محل له… وفي ركن الواجهة كانت ربطة عنق بيضاء منقوشة بنمش أحمر، ملقاة ببراعة فوق أصداف فضية لامعة “ليس من الضروري أن يعيش الإنسان وهو يؤمن بشيء ما يوقف عمره من أجله.. الحياة هي الحياة فقط، مثلما يعيشها الناس…” وقف رجل أصلع إلى جانبي وأخذ ينظر إلى مروحة من الأربطة كانت ملصوقة على الجدار الداخلي للواجهة، ممثلة جناحي فراشة كبيرة: “مثل هذا مثلاً، أعيش كما يعيش، غير ملاحق بأيما شيءٍ ثقيل…”
وحينما تركت الواجهة عاد إلي الفرح بشكل أوضح، وكان الناس يمرون من جانبي، وكنت أنا الآخر أمر من جانبهم، غير ملاحقين بأيما شيء، وعجبتُ كيف لم يتسنَ لي أن أكتشف روعة الحياة على هذه الشاكلة، منذ زمنٍ بعيد..
حتى (أبو سليم)… خادم المطعم العجوز، كان إنساناً جديداً جديراً بالمراقبة، فرش أمامي غطاءً جديداً نظيفاً، وضم راحتيه فوق سترته البيضاء، ووقف ينتظر..
– سوف آكل أي شيءٍ تضعه أمامي..
ابتسم أبو سليم، كان شاربه الكثيف يخفي شفته العليا، وكان حاجباه الرماديان يتصلان فوق أنفٍ شديد الطيبة، وتشع تحتهما عينان صغيرتان، وبدت لي لحيته الخشنة القصيرة أنها تحتفظ بطولها دائماً، وكانت صلعته الصغيرة، هذه المرة، تختفي تحت طاقية مطرزة بألوان خضراء وحمراء وصفراء.. “هوذا إنسان يعيش هنا كما يريد… تماماً كما تعيش، إلى جانبه، أمواج البحر التي تضرب جدران المطعم السفلي كل دقيقة… كالشبابيك الزجاجية التي تطل على الماء المتلاطم… دون أن يحمل ثقل الآخرين… ودون أن يلاحق بهم… أعوام طويلة هنا، ولكنها أعوامه هو، كلها كانت له، ببساطة.. وبلا ثقل…”.
وعجبتُ كيف لم أكتشف أبا سليم قبل اليوم رغم أني أتناول طعامي كل ظهر في نفس هذا المطعم منذ ستة شهور… حتى البحر، البحر الذي يلطم جدران المطعم لم أنظر إليه قبل اليوم: كان مزبداً مرغياً غاضباً، إلا أنه كان، رغم ذلك كله، شيئاً قريباً إلى القلب ولا يخيف…
“أستغني عن عشرين يوماً من عمري لو قدر لي أن أرى سحنته مرة أخرى حين قلتُ له (نعم).. عشرون يوماً كاملاً لو قدر لي أن أرى استدارة عينيه المبغوتتين مرة أخرى..”
رميتُ عقب السيجارة إلى الماء، فطاف فوق الزبد هنيهة، ثم ضاع في الهياج الغاضب، وأشعلتُ لفافة أخرى متطلعاً إلى الأمواج وهي تحمل زبدها إلى الجدران، ثم ترتد مهزومة لتنطوي داخل الماء وتضيع: “دعك من كل هذا… أتريد أن تعيش حياة فارغة؟ مثل أبي سليم؟ عبث بلا مبرر..” كان على الطاولة رجل انتهى لتوه من طعامه، ومضى، متكئاً، يدخل عودة خشبية صغيرة بين أسنانه: “أنتَ سعيدٌ لمجرد أنك غيرت، لا لأنك غادرت..” صفق الرجل فركض أبو سليم تجاهه وأخذا يتحاسبان. “دائماً يحدث مثل هذا.. فكرة إلى الوراء وفكرة إلى الأمام.. ما الذي يمنع أن أكون كالبقية؟” وتصورتُ لوهلة أنني عدتُ إليه، ووقفتُ أمام مكتبه طاوياً كفيّ على بطني: (هأنذا لقد عدتُ ككلب!) كلا! هذا لن يحدث أبداً..
أسقطتُ اللفافة من النافذة، فحملها الزبد إلى الجدار، ثم طواها ومددتُ يدي من جديد إلى علبة السجائر:
– الأفضل أن لا تشعل واحدة جديدة يا أستاذ رياض، وصل الأكل..
قالها أبو سليم وهو يبتسم، ثم دار حولي، ورمى من النافذة قطعاً صغيرة من الخبز كان قد حملها من مائدة أخرى، وقال شيئاً ما بصوتٍ خفيض، ثم أخذ يرتب الأطباق.
– ماذا قلت يا أبا سليم؟
– عفواً، لم أكت أتحدث إليك، كنت أخاطب السمك..
– السمك؟
سألتُ متعجباً واستدرتُ لأواجهه:
– هل قلتُ أنك كنتَ تخاطب السمك؟
أجاب ببساطة:
– نعم
– وماذا قلتَ للسمك الآن؟
استمر في ترتيب الصحون، ثم دفع أمامي رغيفاً وهو يقول:
– قلتُ “اعمل صالحاً.. وارمه في البحر..”
بدا لي أنه اعتاد الإجابة على مثل هذه الأسئلة، لذلك كانت لهجته تحمل قناعة وبساطة دون أن تحمل نغم من يقول شيئاً جديداً..
– هل ترمي الخبز دائماً إلى السمك؟
– الفتات الذي يتبقى على موائد الزبائن.. السمك أحق به من سلة القمامة.. إنني أطعم السمك منذ عشرين عاماً..
كان في صوته رنة فخار بعيدة، ولكنه لم ينظر إليّ، بل قدّم الفوطة، وهز رأسه الواهن، ومضى إلى طاولة أخرى..
أكلتُ لقمة.. إلا أن الفكرة كانت ما تزال تدور في جبيني، نهضتُ ونظرتُ عبر النافذة إلى بحيرة ماءٍ راكد صنعتها صخرتان متجاورتان بين الأمواج، وكانت تتأرجح على سطحها قطع مهترئة من الخبز، وكنتُ أستطيع أن أتبين الأسماك الفضية تتحلق حولها..
عدتُ لأتابع تناول طعامي، إلا أني كنتُ غير قادرٍ على انتزاع نفسي من التفكير بوجه أبي سليم المطمئن وهو يقوم بعمله منذ عشرين عاماً، وبدا لي كل ذلك أمراً لا يبعث على الارتياح. “اعمل صاحلاً وارمه بالبحر…” شيء عجيب إلى حد الذهول.. عشرون عاماً وهو يعمل صالحاً ويرميه إلى البحر!. تراه لو كف عن إلقاء الخبز إلى السمك.. هل سيخسر شيئاً؟
– أبو سليم!
ناديته فجأة، فاقترب حاملاً صحناً فارغاً، ووقف في مواجهتي:
– ولكن السمك، يا أبا سليم، ملايين.. أنتَ لا تستطيع أن تطعمها كلها..
نظر إلي باستغراب، كأنه كان يتوقع مني أن أنسى قصة السمك.. ومال قليلاً ليضع الصحن الفارغ في ركن الطاولة المجاورة، ثم اتكأ على ظهر المقعد المقابل:
– على قدر ما أستطيع يا أستاذ رياض، على قدر ما أستطيع.. أنا لستُ مسؤولاً عن إطعامها كلها.. أنا لا أستطيع أن أطعمها كلها.. ولكن هذا كله أفضل من سلة القمامة.. أليس كذلك؟
تناول الصحن، وقبل أن يمضي التفت تجاهي وهز رأسه وهو يبتسم.. وكان الأمر كله، بالنسبة لي، شيئاً غير مريح.
أكملتُ طعامي مسرعاً وكنتُ غير قادر على وضع الأشياء في مكانها.. استدعيتُ أبا سليم فأقبل ببساطة، ومد يده بالفاتورة.. كان وجهه هادئاً فيه طمأنينة فخورة بدت لي كأنها معجونة في تقاطيعه، وهكذا وجدت نفسي مسوقاً، رغم كل شيءٍ، لأقول:
– يجب أن تكف عن إلقاء الخبز إلى السمك يا أبا سليم..
بقي وجه العجوز هادئاً، ثم سأل:
– لماذا أكف عن إطعام السمك؟
أحسستُ برنة سخرية حادة وعميقة في سؤاله، ورغم ذلك فقد تماسكت:
– أنت لا تعرف أن الخبز يقتل السمك..
أسقط يده برخاوة على جنبه، ثم سأل متململاً:
– يقتل السمك؟ الخبز يقتل السمك؟ كيف؟
شعرتُ بالارتياح. فمضيتُ بالكذبة شوطاً آخر:
– السمك يحب الخبز، لذلك يأتي مسرعاً كي يأكله، ولكن بعد ربع ساعة من وصول الخبز إلى معدته الصغيرة يفتك به، فيموت..
نظر إلى البحر هنيهة، ثم اعتمد على ركن الطاولة القريبة، وكانت عيناه الصغيرتان ترجفان:
– ولكن لماذا؟
سأل بصوتٍ متعب، فيما كانت أصابعه تتشنج وتنفرد فوق غطاء الطاولة:
– لماذا؟ لا أعرف لماذا. ولكننا درسنا هذا في المدرسة منذ زمنٍ بعيد، الخبز يقتل السمك.
نظر أبو سليم حوله ثم ركز عينيه الصغيرتين مباشرة في عيني:
– ولكن السمك يأكل الخبز..
– نعم.. السمك يحب الخبز، ولكن الخبز يقتل السمك..
– يقتله؟
سأل دون أن يعرف كيف يتعين عليه أن يستمر، فهززتُ رأسي، بينما مضى يشد أصابعه فوق غطاء الطاولة، وينظر إلى الماء، أحسستُ الحزن في عينيه الصغيرتين، والأسى في الأصابع العروقة الحائرة..
– لم يقل لي أحد ذلك قبل الآن..
– هذا شيءٌ لا يعرفه إلا طلاب الجامعة..
– الخبز يقتل السمك؟
– نعم..
صفق زبون من بعيد متذمراً، ولكن أبا سليم تجاهله، قلتُ في نفسي: “ربما يحدث هذا لأول مرة منذ عشرين عاماً” أحسستُ بغيظ، فيما استمر أبو سليم، محزوناً، ينظر إليّ، ثم إلى الماء، ثم يتشاغل بالنظر إلى الأرض..
– كنت أرمي الخبز إلى السمك طوال عشرين عاماً..
– عشرون عاماً؟
هز رأسه بحزنٍ:
– نعم.. كل يوم، كل يوم، منذ عشرين عاماً..
أخذ صحناً عن الطاولة المجاورة ومسحه بطرف سترته، ثم أشاح بوجهه وهو يهمس، كأنما لنفسه:
– كنت أعتقد أن السمك يحب الخبز.. ويحبني..
هز رأسه متألماً بينما صفق الزبون مرة أخرى بعنف:
– عشرون عاماً، كل يوم.. كل يوم..
رفع وجهه، فتبينت دموعاً لامعة تتسلل ببطءٍ في شعر لحيته القصير الخشن.
– إذن هكذا.. هكذا..
– ماذا؟
– كنتُ أقتل السمك طوال عشرين عاماً..
هززتُ رأسي وأنا أطبق شفتي بعنف، ورميتُ على الطاولة ثمن الطعام، وخرجتُ إلى الشارع من جديد..
بيروت 1961