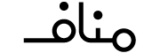حين كنتُ أبلغ أربعة عشر عاماً – أو أكثر أو أقل – سرقتُ من أحد دروج البيت علبة دواءٍ تقول نشرته أنه مضاد اكتئاب، كأي مراهق كنتُ مصاباً به، أو أعتقد ذلك على الأقل، بعد تناولي أول قرصٍ سقطت صريع النوم بشكلٍ مروع، كثورٍ خارت قواه، لم أتحرك أثناء نومي، وقبل سنواتٍ قليلة كنتُ أستيقظ لأجد نفسي تحت السرير، في اليوم التالي تناولتُ قرصاً آخراً، نفس الأمر، وحين استيقظت منهك القوى، اكتشفتُ أن الدواء مخصص لعلاج الأرق – كما تذكر النشرة أيضاً، اكتشفتُ ذلك وكان الأمر ممتعاً، أصبح أكثر متعة حين اكتشفتُ أن هذا الدواء يباع دون وصفة، وأن سعره بالكاد يزيد عن تكاليف مواصلاتي اليومية.
الآن، بعد دزينة من السنوات – أو أكثر أو أقل – أنتظر جرعة مضاعفة من تلك التي كنتُ أتناولها لتأخذ مفعولها، لا شيء، لقد زاد طولي ووزني وكمية الدماء في جسمي، عاقرتُ الكحول واستخدمتُ الكثير من المسكنات، سواء لألم أسناني أثناء تقويمها، أو ألم ظهري الذي استنزفني في عامي الثاني والعشرين لستة أشهر، ربما زادت مناعتي تجاه المسكنات، استخدمته لشهرٍ كامل – أو أكثر أو أقل، متى شئتُ أنام، أتلاشى وأصبح لا شيء، كجزءٍ ساكن من المكان لا يختلف عن سواه، أرمي قرصاً في فمي فيختفي كل شيء، لا أنتظر النوم، بل الاستيقاظ منه دون تذكر تفاصيل انغماسي فيه، ودون تذكري الوقت الذي مر بعيداً عن إدراكي، كدتُ أفقد وعيي في أحد المرات، استيقظتُ باكراً من أجل المدرسة قبل أن ينتهي مفعول الدواء، أنظر إلى كل تفاصيل الصف، وضجيج الطلاب، وكأني لستُ جزءاً من كل هذا، وكأني معزولٌ، وكأني المقعد الذي أرمي رأسي عليه لأنام في كل فرصة سنحت لي، أقاوم، أجاهد وأناضل لأظل يقظاً حتى موعد الاستراحة، أرمي رأسي على المقعد وأنام، أستيقظ عند موعد الدرس، في الاستراحة الثانية انتهى مفعوله بعد الكثير من التبول أثناء الدروس والنوم واقفاً في الحمام، شعرتُ أن الأمر بدأ يخرج من عقاله، توقفتُ عن تناول الدواء، رميتُ به في قمامة المنزل آملاً ألا أذهب ضعيفاً إلى الصيدلية وأطلب علبة أخرى.
خلال الاثني عشر عاماً – أو أكثر أو أقل – ضعفتُ عدة مراتٍ، حاولتُ العودة لاستخدام هذا الدواء علي أتمكن من النوم، لم أستطع أن أتذكر اسمه التجاري، ولم أملك حينها عادة حفظ الاسم العلمي للدواء الذي أتناوله، الاسم المشوه الذي تمكنتُ من تذكره كان يقدم لي في الصيدليات المزيد والمزيد من الأسماء التجارية للإيبوبروفين، أكوامٌ من الحبوب زهرية اللون التي تناولتُ المئات منها أثناء تقويم أسناني، أصبحت بالنسبة لي قطعاً من الحلوى أكثر منها مسكناً متوسط المفعول، لجأتُ مرة إلى صيدلية أهل صديقتي التي تستخدم حبوب النوم بدورها، لكن دون فائدة، ووالدها كان متعنتاً يرفض تجاوز الوصفات الطبية، على عكس الصيدلاني في منطقة سكني، لا أريد استخدام دواء آخر، أريد القشعريرة، “التنميل”، الشعور بأجزاء الجسد جميعاً كأنها واحد، لا تمايز بينها، لساني، أصابعي، قضيبي المنكمش، حتى أظافري، يختفي التمايز، أصبح وحدة لا تتجزأ، لا تنفصل، متساوية أمام الله والتخدير.
جربت الكحول، سخيف، بعض الهذيان الصبياني، ثم لا شيء، والمزيد من الأرق، أريد أن أنام، الوحدة بين أجزاء جسدي يجب أن تستحيل وحدة ساكنة مع خواء المكان من حولي، لا تسقطني الكحول صريع النوم البهائمي لأصير جزءاً – من الداخل والخارج – من السكون.
أخبرني نصٌ مخصص للمطالعة في كتاب علم النفس أن الإنسان يفقد وعيه حين يواجه خطراً أو خوفاً أو صدمة – لا أتذكر بصراحة – أكبر من احتماله، كوسيلة دفاعية لتفادي الشعور بالخطر، لم أؤمن يوماً أن النعامة مخلوقٌ جبان، إنها قادرة على قتل إنسان بقدمها فقط، لِمَ يخاف أو يكون جباناً من يستطيع أن يقتل إنساناً؟ أعتقد أن النعام بكل بساطة يخفي رأسه ويخفي العالم من حوله حين يدرك أن الشجاعة لا تنفع، بل ربما سلوكه أكثر شجاعة من الآخرين، يدس رأسه الصغير في التراب، ويقول للقدر اقتلني، ولكنك لن تجبرني على المشاهدة، أمر يشبه هربي من المقهى عند إذلال البرازيل، صمدتُ حتى الهدف الخامس وانسحبتُ، كنعامة دسستُ رأسي في تراب غرفتي، لم أكرر خطأ ارتكبته قبل ستة عشر عاماً، أذلوهم، اقتلوهم لو شئتم، ولكنني أستطيع الابتعاد عن التلفاز أو تحطيمه أو إطفاءه، ولن تجبروني على المشاهدة.
مرحباً، أنا تيم. خاوٍ من الداخل، ومدمنٌ على الألم وطعم الدماء في فمي.
أكره أن أفكر بأمرٍ واحدٍ طوال النهار، قيمة الوقت عندي ليست في تلك الأحداث اليومية السخيفة التي نعيشها، تلك عديمة القيمة، نسخة عن نسخة عن نسخة عن أصلٍ رديء، المثير للاهتمام هي تلك الأخيلة والأفكار والأزمنة التي تدور في رؤوسنا طوال النهار، رأسي على الأقل، أكره أن أهدر يوماً من المخيلة على أمرٍ واحد، الأسوأ أن يكون من الواقع، بكل تفاصيله المعتادة حد الغثيان، بكل حدوده التي تحول الحياة الممكنة إلى سخافة لا تنتهي، كمسلسلٍ لا يتابعه أحد، كل يؤدي دوره ويتابع، ولكن ما من أحدٍ يتوقف، يأخذ نفساً، ويتناول قنينة ماءٍ صغيرة يشرب منها وينظر حوله، ويقول “فلنرَ ماذا لدينا هنا”، سخيفون كرقصة يؤديها مجموعة هواةٍ مصابون بسمنة مفرطة.
مرت علي الآن ثمانٌ وأربعون ساعة منذ تناولتُ القرص الثالث، ومازال لدي بعض الأمل أن يأتيَ أثر متأخر جداً، أن أكون قد تسببتُ لجسدي بصدمة ما، أن أشعر بشيء، جسدي منهك، كمنزل مخلوع الأبواب والنوافذ، أنهكت جدرانه تحرشات الرياح، بالكاد أقضي عشر دقائق على كرسي أو أريكة، فيبدأ جسدي بالعويل، ويصرخ أن ألقي بيَ على سرير أو فراش أو حقل من الأرز، يقول لي تمدد، تيار الكون المار منك لا يحتمل الالتواء، بل يسير مستقيماً، طويلاً، كدربٍ يندر أن ينتهي.