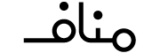هذا الروتين اليومي يذبحني، لا أعرف ما الذي أنتظره، نهاية ساعات العمل، أم نهاية النهار، أم نهاية الأسبوع، أم نهاية عطلة الأسبوع، حلقة تدور حول نفسها ولا تتيح نظرة عبر نافذة أو باب موارب لأعرف ما إن كانت تسير إلى الأمام. وما أهمية سيرها إلى الأمام أصلاً إذا لم يكن مسموحاً لي بالترجل؟
تُسلب الأحلام منا رويداً رويداً، والنور الذي نسير نحوه يمسي سماءً متوسطة الإضاءة، الكلمات الكبرى التي كانت أجنحة تحلق بنا تستحيل رخاماً يثقل كاهلاً وتجعل حتى السير عناء. أقفز من صباحٍ إلى صباحٍ كسجينٍ تعب من إحصاء أيام العقاب، أقفز من مساءً إلى مساءٍ كطفل محبوس في خزانة يخرج منها لاستراحات حمامٍ وماءٍ ريثما يعود للاختباء، أختبئ خوفاً من أشباح الماضي الذي يسأل بكل حماسٍ عما حصل، أختبئ محرجاً من صوتي قبل أن تعكره موجات الشيب المتتالية، وأسأل نفسي لماذا البقاء؟
ها هو التاريخ يسير بي وبدوني، ما فائدة مدّ يديّ من النافذة إن لم أبطئ سير المركبة؟ أكي أقول ساهمتُ في تخفيف وطء الكارثة؟ هل ساهمت أصلاً في تخفيف وطء الكارثة؟ ها هو التاريخ، إن تعثرتُ بطرفه لا يتلفت ليرى ماذا سقط. سيارة بلا فرامل ولا عجلة قيادة، جسم معدني يبتلع سنين حياتنا، إما يأخذنا حيث يريد، أو يجرجرنا خلفه كعلب قصدير سرعان ما تنفلت حبالها وتتحول لغذاءٍ للشمس الحارقة وغبار الطريق.
–
كان لديّ وطنٌ صغير. خمسة أبنية وجامع ومدرسة. كانت لديّ مخيلة شاسعة، تقحم الكون وتواريخه في خمسة أبنية وجامع ومدرسة. ثم استضاق، ونافذة المنزل صارت غيمة تخيم فوق بصري كل الوقت. ثم استضاق، وبتُ مصلوباً أمام شاشة أصغر من النافذة أمدّ يدي بحثاً عن رغيف خبزٍ أو كأس خمرٍ وأجري وراءها. ثم استضاق، وبت سمكة منفية خارج مياهها كل ما تبقى من حياتها ارتعاشات متقطعة.
كان لدي وطنُ صغير. أعرف فيه أسماء الجميع، وأهز برأسي لكل وجه يعبر قرب وجهي، نتكلم لغة واحدة، وإن شئنا نقفل الباب على الكون خارج أبنيتنا الخمسة والجامع والمدرسة. كنتُ ألمس الجدران فتشدّ على يدي، وألمس الهواء فلا يهرب مني. لم نكن نعرف المستقبل ولكننا لم نخف منه، ثم بتنا نعرف القليل منه، فوقعنا في غرامه، عرفنا أكثر، فبات رعباً ينغص نومنا، وفجأة انفتح المستقبل على مصراعيه، ولم نجد فيه شيئاً مما عرفنا.
كان لديّ وطنٌ صغير وعائلة كبيرة. أصوات الجيران التي تصعد سُلّم البناية نحو منزلنا أميّزها من النغمة الأولى، أما الآن وقد تقدمت السنين، أصبحت فتيات البناء نساءً وتزوجن ورحلن بعيداً، لا يأتين إلا زيارات عابرة مع أطفال ورجالٍ لا نعرفهم، أما الصبية فخشنت أصواتهم وصارت متشابهة. محاطاً بالأصوات الغريبة كمدينة محاصرة، رحلتُ عن وطني الصغير.
ألبوم الذكرى منقوص، مزقتُ صفحاته الأخيرة، تركتها تسقط في مياه النسيان وتتلاشى ألوانها أملاً بأن تبدأ قريباً خطوطها بالتلاشي كذلك.
–
أنا سجينٌ، رهينة إن شئتم. العالم الذي كنتُ أظنه ملعباً فسيحاً انكمش فجأة وأخذ هيئة لصٍ وضيع يضغط صدغي بفوّهة مسدسه. قذف بي إلى زنزانة بعيدة، لا يمرّ عليّ ليمنحني طعاماً أو شراباً أو حديثاً ألوكه. لص وضيع لا يشفق على الفقير ويسرق منه حتى مناشفه ومناديل مرحاضه ونصف كأس الشاي البارد الذي احتفظ به من أجل السيجارة التالية.
فتحوا البوابة دقيقتين وقالوا لي لملم حياتك واخرج، وعلى عجالتي لم أستطع أن أجد شيئاً ألملمه، استعرتُ بعضاً من حياة الآخرين، مِزقُ الصور نثرتها في حقيبتي ولم أتوقف لأحصي ما دخل منها الحقيبة وما ابتلعه بلاط السجن، وخرجتُ مسرعاً نحو فضاءٍ فسيح. سجنٌ آخر، سنين أخرى تمشي ببطء على جسدي، ولكنها أوسع قليلاً، تتيح لي النوم مستلقياً كما لو أن أسفل ظهري سرير، تسمح لي بالسير خطوات إضافية مغمض العينين حالماً بغاباتٍ وسهولٍ وحدائق أقطعها.
أشتاق أحياناً، كأي أحمق يسمع بالحرية ولا يذوقها، إلى زنزانتي، ولكنني مسجون خارجها. مسجون خارج العالم الفسيح وخارج الزنزانة الضيقة. مرمياً في فضاءٍ واسع ثقيل على رئتي، لا يتاح لي تنفس هواءً يطير، ولا تنفس هواءٍ قليل يصبح صديقي وأعتاده.