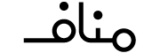أجلس في مقهى “كتّاب” وأراقب مئات الكتب التي تملأ الجدران حولي، هذه زيارتي الثالثة أو الرابعة لهذا المكان، ولا يبدو أن تغييراً يذكر قد طرأ على ترتيب الكتب أو العناوين التي تملؤها.
ماذا لو كانت هذه الكتب زجاجات خردلٍ منخفض الحريرات أو بيضاً عضوياً؟ هل كانت ستصمد على هذه الرفوف لستة أشهر كاملة؟ لا أعرف تماماً معنى مصطلح “المثقف العضوي”، ولكنني واثقٌ من أن كلمة “عضوي” فيه ليست كافية ليباع بسعر أكبر كما هي الحال بالنسبة لكل هذه الفواكه والخضراوات مضاعفة السعر لأنها “عضوية”.
هذه الحياة التي نحياها الآن هي مواجهة بين من لا يقرؤون ومن يقرؤون، بين من يكتفون بأي شيءٍ يرمى في مذودهم ومن يغادرون حظيرتهم بحثاً في البرية عن طعام جديد، مواجهة الفائز فيها معروف سلفاً، معظم البشرية أصبحت قادرة على القراءة ولكنها بالكاد تقرأ أكثر من أدلة الاستخدام والسوشيال ميديا، الصحف رخيصة ومتوفرة للجميع، ولهذا هي الخيار الأفضل لتغليف الأطعمة وتنظيف النوافذ.
ورغم ذلك، ما زلنا – نحن الموسومون بلقب المثقفين المتندر عليهم من قبل كل السفلة وأنصاف الناطقين – نكتب، لمن نكتب؟ الوقت اللازم لكتابة رواية أقل من الوقت اللازم لبناء عضلات الجسم المغرية، والأخيرة تجلب عدداً أكبر من النساء إلى الأسرّة. لمن نكتب؟ الجهد اللازم لتصوير فيديو يحتوي على 200 كلمة ونصف معلومة لا يكفي لكتابة ربع ربع مقال أو تقرير صحفي، وهو أقدر على جني المال وبناء الشهرة وإلقاء المواعظ على الفاشلين.
لمن نكتب؟ لمن يسمعون الأغاني التي يرميها لهم الراديو كرغيف خبز جاف؟ لمن يقيمون العمارة بتكاليف مواد إنشائها؟ لمن يقيمون الممثلات بناءً على قياس أثدائهن؟
ثمانية مليارات من البشر! ألا يستحقون أن نتحدث إليهم؟ ألا يستحقون أن نتعلم لغة يفهمونها، لغة لا تحتوي كلماتٍ، وإنما مؤخرات رجراجة وأثداء لينة، أضواء باهرة ورجال يقذفون الدم من وجهك بلكمة واحدة؟ هؤلاء هم الأكثرية بالتأكيد، وهم من سينبحون في وجهك حين ترفض الاعتراف بممثلتهم الإباحية المفضلة كقفزةٍ نوعية في المسرح الحديث، وهم من سيقررون ما هو “المسرح” وما هو “الحديث”، ولكن أي منهم لا يملك إكسير الخلود.
نكتب، ونقولها بكل عجرفة وتكبر واستصغار للآخرين، للقلة القليلة التي تعرف اختيار من يستحق الخلود، للقلة القليلة التي تملك إكسير الخلود.