قرأتُ مؤخراً بعض المقتطفات من “مرايا فرانكنشتاين” لعباس بيضون من أجل مقال أكتبه، والآن حين أفكر كيف يبدو وجهي كما أؤمن أنه يبدو، لا كما يبدو في الفيديوهات والصور، فإنه بالنسبة لي وجه شون بين. لا أعرف إن كانت علامات التوحد في وجهه هي مصدر نجاحه في “أنا سام” أم العكس هو الصحيح؛ يمكنك أن تلاحظ علامات التوحد في وجهه بسبب هذا الفيلم الرائع. لم تجذبني يوماً العلاقات التي تشغل جل صفحات الكتب التي أقرؤها، أو الأفلام – القليلة التي أشاهدها – أو حتى المسلسلات، جميعها تتكلم عن الحب أو الصداقة، علاقات تنتهي فيها الأزمات بسرعة، ويعيش طرفا العلاقة أوقاتاً سعيدة أو تعيسة حتى نهاية حياتهما.
العلاقة بين الأب والبنت، الأخ الأكبر والأخت الصغرى، أي علاقة بين فردي عائلة مختلفي الجنس مع فارق كبير في العمر هي الاختبار الحقيقي للمحبة، التواصل الذي تتغير قواعده كحربٍ كل سنة أو أقل. أشتاق لعناق حبيبتي في غربتي المعقولة حتى الآن، ولكنني أكثر ما أشتاق لوجود أمي في الغرفة المجاورة، للصباح – الذي كان يبدأ بالنسبة لي عند الظهيرة – مع والدتي، نشرب القهوة سوية ونتكلم عن كل معارفنا المشتركين، وأحكي لها دائماً عن حبيبتي كمثال ناصع عن السلوك القويم.
أكتب أخيراً بعد غيابٍ، ربما احتجتُ لمساعدة بعض أقداح التيكيلا والبيرة (اسمها ليس جعة يا سفلة) التي أكملت نصفها مدعومة ببعض التيكيلا أيضاً مع شريحة من الليمون، واحتراماً للكتابة ألبس بوكسراً، لا أستطيع للمرة الأولى أن أدعوه “سروالاً داخلياً”، فهو ليس سروالاً، وفي دمشق قلما ارتديته ما لم أكن واثقاً من أنه سيكون قطعة الملابس الوحيدة التي أرتديها، وبالتالي ليس داخلياً.
شون بين.. لو أن لي عينيه الملونتان فقط، لو أنني بنصف جماله فقط. حين أتردد بخصوص حبيبتي الجميلة، أفكر بعينيها الجميلتين، أفكر برائحتها التي تجعل السماء تبدو أكثر اتساعاً، وبشعرها الذي يجعلني أتلمس فروة رأسي بقرفٍ، ويتلاشى كل التردد، فأنا وإن كنتُ لن أتزوج امرأة تشبهني، فإنني على الأقل سأتزوج أجمل نساء الكوكب على الإطلاق.
شيءٌ ما مختلفٌ اليوم. خلدتُ إلى النوم مقرراً ألا أدخن اليوم، واستيقظتُ مقرراً أن أدخن نوع سجائر مختلفٍ عن ماركة التوفير التي أدخنها حالياً. جربتُ حوض الاستحمام للمرة الأولى في حياتي، ثلاثون عاماً ولم أغطس في حوض استحمام. شعوره يشبه حوض السباحة، ولكنه أكثر رعباً لأن أطرافي لا تملك المساحة التي أملكها عادةً في حوض السباحة، أو المياه الضحلة للشاطئ التي جربتها هنا مؤخراً.
الكتابة فعلٌ صعب. والآن، فيما أحيا الحياة التي يعيشها معظم كتاب الكوكب، ساعات العمل الطويلة، والمعارك التي يحتاجونها لقراءة كتاب أو كتابة سطرين من رواية أو قصيدة، أوشك على الوقوف احتراماً لهم، لولا أنني سأعجز عن الكتابة بفعالية على لوحة المفاتيح واقفاً.
الكتابة وحبيبتي، شيءٌ ما يجمع بينهما. قلما أنشر شيئاً عنها. أكتب لها وعنها الكثير من النصوص نتشاركها فيما بيننا دون عيون وعقول الغرباء، ولكن في النهاية أعرف أن شيئاً ما يجمع بينهما. إنها مثل كتاب جميل، لا تقرأ مثله إلا نادراً، وتمر أيامٌ وسنوات، وتبدأ بفقدان تفاصيل الكتاب الجميلة، ولكن تتذكر دائماً أنه كتابٌ لا مثيل له، صفحاته رحلة تتمنى لو أنك تحيا فيها، لو أنها تستمر إلى الأبد، لو أنها تكون جزءاً من الدورة الطبيعية للحياة. حبيبتي كتابٌ سيستمر إلى نهاية أيامي، وأعرف أنه كتاب لن أمل من قراءته.
رغم أنني أنهيتُ حديثي معها بوجه متجهم – هو وجهي اليومي لا أكثر – ورغم أنني منزعجٌ من نافذة منزلي التي بالكاد تفتح لثلاثين سنتيمتراً، بحيث علي أن أفقد 50 كيلوغراماً كي أتمكن من الانتحار، فإنني أشعر بالسعادة، ورغم كل الحسابات المعقدة التي أجريها كل يوم كي أعرف متى سنصبح سوية وأعرف متى سيتسنى لي الجلوس في غرفتي الجميلة مجدداً، فإنني الآن… سعيد، لا لشيءٍ، سوى لأنني أكتب من جديد، لابساً بوكسراً احتراماً لقدسية الكتابة.
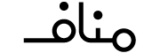
احببت كثيرا النافذة التي ستحتاج لفقدان ٥٠كغ كي تعبرها ..المناخ كله..الصراع من أجل كتابة سطرين .أو قراءة صفحات …والأغنية المرافقة..
كتابة تلمس مساء سبت رمادي من دون شريحة الليمون