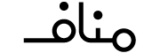منشور في مجلة الجديد يوم 1 أيلول 2016
حين أفكر بالأمر الآن، لا أتذكر سوى جدران حديقة المنزل الخلفية المتقاربة، والأغصان المتشابكة المخيمة على زاويتها كدبٍّ ينقّب في النهر، أتذكر حرقة الجروح على ظهر يدي، المخالب مرت وتركت ثلاثة شطوب واختفت قبل أن أراها، تغيب عن ذاكرتي المسافة بين إصابتي وانتقالي لداخل المنزل محاطاً بعائلتي والضيوف والنور المجذوم الذي تسربه نوافذ بعد الظهيرة، الذعر مخلوطاً بالضحك يحيط بي، وأنا أقف جامداً لا أجيب أحداً، أشعر بحرقة شديدة في الجرح الأول من اليمين أكثر من الآخرَين، وداخلي، في قاع وعي طفلٍ في الخامسة من العمر، يتغير شيءٌ ما إلى الأبد، ومؤخراً تنزاح قارات دخيلتي ويطفو قاع المحيط إلى قمم الجبال.
كانت الدنيا بالنسبة إليّ ثلاثة شوارع أثناء السنوات القليلة التي أتذكرها في حينا القديم، شارع منزلي، شارع السيارات إلى يسار المنزل، والشارع الخاوي المؤدي إلى فرن الخبز ومدرستي على يمين المنزل، الأول هو شارعي، الثاني هو دمشق، والثالث هو كل الحياة التي ظننتُ أنني سأواجهها، لا تتنوع الزهور في حينا، فقط الكثير من الياسمين المتشح ببقعٍ سوداء صغيرة تدون حركة عبور السيارات، مللتُ هذه الزهرة الطاغية حتى قبل القدرة على تسجيل الذاكرة، ولكنها في دنياي الصغيرة كانت كل الزهور.
كانت الدنيا بالنسبة إليّ أنا وجيراني وعائلتي، وبعض الغرباء لا يتجاوز وجودهم طابوراً صغيراً أمام الفرن، أو صورا ينقلها مشوشاً زجاج السيارات، وكان الكل واحداً، لا أحد يقف في وجه الآخر.
نظرتها نحوي تبدو حين أتذكرها الآن محذرة بجلاء من الاقتراب، ولكن في تلك السن لم أستطع ترجمة وجه قطة غاضبة، كنت أحمل غطاء علبة مرطب اليدين وفي داخله بضعة زهور ياسمين قطفتها من الحديقة، بوصفها زوائد لا لزوم لها ولن أساءل عنها أمام والديّ، لا بوصفها تعبيراً مبتذلاً عن المحبة.
كنتُ سعيداً باستمرار وجود حيوانٍ في حديقتنا وأريد الترحيب به، لستُ مبرمجاً عبر التلفاز ومراقبة الأغنياء بما يكفي على مداعبة الحيوانات الأليفة، ولا الأوقات التي لا يجب فيها الاقتراب منها، واعتقدتُ أن بإمكاني أن أقدم لها هدية عشوائية من أيّ زوائد متوفرة في المنزل، كما كنتُ أفعل لبعض أفراد العائلة، مرحباً بها في حديقتنا، وبمواليدها في الحياة.
حين أفكر بالأمر الآن، لا أتذكر سوى الجدران والحديقة، لا أتذكر سوى نظرتي الأخيرة على العالم قبل أن يتغير، أخبرني الجميع أن السبب كونها تحتضن أطفالها المولودين حديثاً، والقطة تكون عنيفة في هذه الأوقات، لم يكن الأمر بيولوجياً بالنسبة إليّ، لم يكن جزءاً روتينياً من الطبيعة، كانت المرة الأولى التي لا أشعر فيها بالأمان، كل الأخطار التي واجهتها حتى ذلك الحين، كل الأوضاع المقلقة والتهديدات بالخطر لم تكن سوى مداعباتٍ من الآخرين للطفل الأصغر في العائلة، وفجأة اكتشفتُ أن وجود من يرغب بإنزال الأذية بي ليس أمراً مستحيلاً.
لم تترك الجراح أثراً، ولكنني حين أنظر ليدي اليسرى أرى مواضعها الدقيقة، أراقبها تصغر إذا كبرت يدي.
الحلقة الأولى من سلسلة طويلة، أحبس في صهريج ماء فأكتشف أن الأشياء يمكنها أيضاً أن تؤذيني، تغرقني على سبيل المثال، ننتقل إلى ضاحية شبه مهجورة فأكتشف أن المدن يمكنها أن تؤذيني.. وتستمر المسألة، تندلع حرب، فأكتشف أن حتى الأفكار تستطيع قتلي، الكلمات تستطيع قتلي، وحين يتجول جزار أمام باب غرفتي؛ تنفسي يستطيع قتلي.
تقدمتُ في السن، واكتسبتُ عادة اللطف والحرص المفرطين مع الأطفال، أخاف أن أكون محاطاً بالمدينة الفاضلة لأحدهم، أن أكون الحجر الأول سقوطاً من هيكلهم، أن يُلبسوا بؤسهم وجهي. أجبرتني الطرقات المغلقة في الحرب على التجول في الحي القديم من جديد، وحين تعبر قربي قطة هناك أتهيّب، أتذكر وجه القطة الذي ألبسته لنذالة العالم، عالم يقدم طفل له الزهور، ويرد عليه بمحاولة قتله.