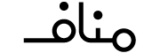ربما آن الأوان لبعض العري في الكتابة، لا اسم لها – مؤقتاً على الأقل – ولا تاريخ ميلاد، بالقرب منها يسير الزمن في اتجاه مغاير – غير معاكس – للمألوف، وتحديد موعد ميلادها فكرة مستحيلة التطبيق، ضئيلة، كغرفة تحتبس كل شيءٍ داخلها، ألمسها، أحياناً أتعمد التجول على عروقها البارزة، أشعر بذباتٍ قليلة تنبئ بالضجيج، ولكنه بعيدٌ مكبوت، يعاد تدويره في مكان واحد بأقل كمية هدرٍ ممكنة، أقترب أكثر، ألامس الأضلاع، أغرس أصابعي بهدوءٍ بين فراغاتها الباردة، هناك الضجيج معدوم.
ربما آن الأوان لبعض العري في الكتابة، لا اسم لها – مؤقتاً على الأقل – ولا تاريخ ميلاد، بالقرب منها يسير الزمن في اتجاه مغاير – غير معاكس – للمألوف، وتحديد موعد ميلادها فكرة مستحيلة التطبيق، ضئيلة، كغرفة تحتبس كل شيءٍ داخلها، ألمسها، أحياناً أتعمد التجول على عروقها البارزة، أشعر بذباتٍ قليلة تنبئ بالضجيج، ولكنه بعيدٌ مكبوت، يعاد تدويره في مكان واحد بأقل كمية هدرٍ ممكنة، أقترب أكثر، ألامس الأضلاع، أغرس أصابعي بهدوءٍ بين فراغاتها الباردة، هناك الضجيج معدوم.
يبدو أن لقاءاتنا ستكون قليلة، وأكاد أجزم أنني في نهايتها سأكون مشغولاً بامرأة أخرى، لا بد من الكتابة الآن، حين تجد نفسك عارياً لا تختبئ، قدم غنائية لأعمدة الإنارة، لا تكترث أنك الوحيد الذي يرقص. يبدو أن لقاءاتنا ستكون قليلة، وكون لقاءٍ واحدٍ دفعني للكتابة يوحي بضرورة التخفيف من هذه اللقاءات، أن تنتقل فتاة من كونها صديقة إلكترونية لم تسمع صوتها حتى، إلى امرأة تلتهم لسانها في الشارع في أقل من ثلاث ساعات، هو أمرٌ تحتاج بعض الوقت لاستيعابه، وإن كانت الأمور بهذا الثقل في كل لقاء، فلا بد من التقليل قدر الإمكان من هذه اللقاءات.
حين رفضتْ أن نلتقي في اليوم التالي، قالت أنها تريد أن تخزنني، وصفت نشاطها في هذه الليلة؛ “أذكرك”. أدركتُ أنها امرأة لا ألتقي شبيهاً لها كل يوم، ولولا صغر سني لحسمتُ بأنني لا ألتقي بها سوى مرة في العمر كله.
[خطف إلى الخلف]
موعدنا يوم الثلاثاء الساعة السابعة، “وسوف آتي حتى لو لم تأتِ، عبثاً بقدري”، مرت علي ثلاث سنواتٍ طوال، دون أن يكون لدي عمل منتظم التوقيت أو دوام في الجامعة، الزمن عندي أمرٌ ثانوي، دائماً هناك وقتٌ لأي شيءٍ، في الصيف أنام طول النهار، وأكتفي بالليل البارد والقصير، في ظل هذه الميوعة من الزمن لم أكن أضرب موعداً قبل يومين أو ثلاثة، أكتفي باتصالٍ قبل ساعتين.
أن يكون هناك موعدٌ بعد أسبوع من الآن يجعل الوقت يمضي ثقيلاً، وكأن أظافره تقاوم مغروزة في زوايا المكان، تطول الأحاديث بيننا كل يوم ويصبح الزمن أثقل، تبدو عارية أكثر مما يجب، أو أنها مقلوبة عند الكلام معي، قاعها سطحها، وسطحها في القاع بعيداً جداً، أصاب بشعور غريب أن هذه الفتاة التي أعرف مختلفة تماماً عن تلك التي يعرفها الآخرون، حفر الحزن عميقاً داخلها، أستبعد أن يكون السبب موت والدها، لها قوقعتها الخاصة بها، تكلمني وكأنها في مكانٍ بعيد، كوكب نبدو منه جميعاً ضئيلين جداً.
لا يمكنك توقع أي من كلماتك سيترك الأثر الجيد لديها، أو أي منها “سيبعصها”، كل ما يمكنك تخمينه هو أنك لن تفهم الكثير، سواء بسبب حروف الجر المشوشة في ذهنها، أو عدم توفر مساحة لمزيد من الفهم، ألقِ نظرة واحدة على كل رف من متحفها واعبر، فسر الأمور كما شئت، بكل الأحوال ستكون قد سبقتها إلى محاولة التفسير، الحديث إليها كأن تشاهد فيلماً لوحدكَ، إن فاتك سطران أو ثلاثة ليس هناك من تسأله “ماذا قالت؟”، ولا يمكنك إرجاعها إلى الوراء، ما زالت فوضوية في السفر عبر الزمن، أقترب منها، أشم رائحتها بنهم من زاوية العنق، أضيف بعض الواقعية إلى المشهد.
تغييران جذريان أو أكثر أصابا حياتي في هذا الأسبوع، ولكنهما مرا بخفةٍ، الشيء الوحيد الثقيل والمرهق الحديث معها، علي أن أقاوم كل يوم الرغبة بإنهاء الحديث وإلغاء الموعد، كان من السهل أن أرى الاتجاه الذي تتخذه الأمور، ولكن لم أدرِ إلى أين يؤدي هذا الاتجاه، أكرهها – وليس من باب المزاح أو الفوضوية العاطفية – بصمتٍ وأشتمها في وجهها وحنجرتي، أطلب منها أن تكف عن تحليلي، ولكن يبدو أنها تستمتع، أرى بوضوحٍ ما الذي تفهمه من فوضاي، ولا ألومها على النتائج الكارثية التي تصل إليها، فأنا بالكاد أفهم أياً من أفعالي أو أقوالي.
كل شيءٍ يأتي بلا مقدمات، لا “مرحباً” ولا “أهلاً”، فقط “حاكيني”، وريثما تأتي “وداعاً” فجائية بلا مقدمات أيضاً، أظل في مساحة من اللايقين، كل تفاصيل الوعي عندي تصير خلايا جذعية من الممكن أن تصبح أي شيءٍ، حتى أعصاباً في أماكن غير مناسبة، أثناء خضوعي لإغوائها الشيطاني أشعر بأجزاءٍ مني يفترض بها أن تكون صماء، أستسلم لإغواء مديحها لثلاثة أو أربعة سطورٍ، أشعر بسخافتي، من قد يمدح مسخاً كهذه؟ أتراجع، أعرف أن تراجعاتي التكتيكية “تبعصها”، فأتراجع، كشبحٍ يبتلعه شعاع الشمس الأول.
لا يمكنني الاتصال بها، إنني حتى أجبن من متابعة الكتابة عنها، أتهرب وألهي نفسي بأمورٍ لا قيمة لها، أتهرب من حقيقة أنها دفعتني إلى الكتابة، مع كثرة الراغبات بالأمر، يصبح التمنع عن منحه ممتعاً، ضرورياً ربما.
منذ بدأت هراء الكتابة، أؤمن بلوحة المفاتيح، أجد الورق أهزل وأكثر قدرة على الزوال من أن يكون أرض معركة ثقيلة كالكتابة، وببعض التساهل أؤمن أيضاً أن المفاتيح بإمكانها أن تنقل مشاعرنا وارتجاف إصبعنا، شعرتُ بارتجاف إصبعها، وأصر أن ذلك هو السبب الوحيد الذي دفعني للذهاب إليها، كنتُ أريد أن أؤنس وحدة فتاةٍ صغيرة، كنتُ أريد أن أقوم بفعلٍ جيد أذكره عند الحاجة، لم أكن أبحث عن مغامرة، أعتقد بشدة أنني لم أكن أبحث عن مغامرة.
طلبت منها أن آتي، رفضت، رجوتها، قالت “تعال”، وفي الطريق آمنتُ بشدة أن رواية الياطر هي مصدر اسم المكان الذي التقينا عنده، هي تحب الإغواء الأخير للمسيح أيضاً، الروايتان جاءتا في أوقاتٍ مناسبة، الإغواء الأخير للمسيح جاءت في سنين تأملي العشر لآلامه، والياطر جاءت في سنين تأملي العشر لوحدتي، كنتُ أبتسم لفكرة اعتبارها حسيبة، راعية البقر التي تؤنس عزلتي على تلك البقعة القاصية من الشاطئ، أعتقد أن رعاية البقر ستكون مهنة أكثر إثارة للاهتمام من مهندسة، مهندسة… ثقيلة على السمع، فيها شعور تلقائي بالعري.
جسدها ضئيل، وجهها… محيّر، كل شيءٍ كما توقعت، حتى دقائق الحيرة التي كانت تصيبني عند الغرق في تأمل الندوب الكثيرة على ساقها اليمنى، لم أصدق كم كان تلمسها أمراً مثيراً للغثيان، كانت تستفزني الدقة في تسرب الإيحاء من خلايا بشرتها إلى رؤوس أصابعي، كصعقة كهربائية تنتشر في مجمل جسدي في ثوانٍ معدودة، أشعر بها برودة وارتياح يعبران أوعيتي الدموية ومن ثم لب عظامي.
أطلب منها أن ألمسها، تتصرف بطبيعية – مصطنعة أو غير مقصودة – وتمد لي ذراعها اليمنى، وتكمل الموضوع الممل الذي تتكلم به أياً كان، لا أكترث، المهم أن تتكلم وتتركني براحتي مع عروقها البارزة، موجاتُ صوتها تعبر إليّ الآن عبر بشرتها أكثر مما تفعل عبر أذنيَ، تصبح بعض خلاياها الشقية جزءاً من رأس إصبعي لثوانٍ، ثم تفارقها، وتتركني أبحث من جديد عن أشقياءٍ آخرين.
ألمح بعض الندوب الجديدة على الفخذ الأيمن، أمد يدي دون استئذان، أرفع التنورة قليلاً، وأتلمسها هذه المرة بباطن كفي، أهمس بعبارات التعجب، أبهرني الماضي المدفون هنا، ذلك العاجز حتى عن الصراخ. انتهت علبة السجائر، علينا أن نذهب، كان الاتفاق بهذا الخصوص ضمنياً، كما هو كل شيءٍ منذ ألقيت عليها التحية الأولى، خرجنا، سرقت مني خمسين ليرة، ولا أعتقد أنها تنوي إرجاعها، لم تكن مشكلة كبيرة، ولكن الأمر بدأ يزداد غرابة حين مررنا بمكانٍ مظلم، وكانت أجسادنا تصرخ – كلانا كان يسمعها – لتلتصق، ونحن نمنعها، لم يشعرني الظلام بالأمان، أن أقبلها، أو أعانقها، أو حتى أضربها، بدى لي الأمر جبناً، لم أكن أشعر بالفعل بانجذابٍ مبررٍ نحوها، كنتُ أسأل جسدي “هل أنتَ جاد؟” فيهز رأسه موافقاً، الحوار السخيف نفسه كان يدور مع جسدها أيضاً.
تجاهلتُ تلك التحرشات الصامتة التي يمارسها علي كل ما حولي حتى جسدي، وجدتُ كتفيّ يهزلان وينزلان قليلاً، وجدتني أتخلى عن نفسي، وصلنا إلى حديقة بلا سور، محاطة بصفٍ من الحجارة وبعض أحواض التراب الخالية، قفزنا فوق أحدها، وجلسنا، على الكرسي كانت أقرب من أن أتجاهل الموضوع، أنهض مرتين أو ثلاثاً لأدهس عقب السيجارة الخاص بها، الخاص بي هي تدهسه، ذلك أعطانا استراحات قصيرة، كنتُ بغنىً عنها لعدم فائدتها، بدأتُ بتحرشاتٍ طفولية لمنعطفات ذراعها وأضلعها، كانت مجرد رحلات قصيرة لاكتشاف نُحلها.
قبلتي الأولى كانت في هذه الحديقة، عادتْ بي هذه الفكرة إلى ما كان يخطر لي في الأيام القليلة الماضية؛ أن الأغلبية العظمى من اللحظات الهامة في حياتي تنحصر في أقل من 25 كيلومتراً مربعاً، وها أنا أصر على إضافة المزيد ومراكمة الذكريات في المكان، ربما في وقتٍ قصير سيزدحم الهواء من حولي بالملل أكثر من الآن، ربما عليّ أن أهرب قبل أن تستيقظ ذكرياتي دفعة واحدة كزومبي، وتلتهم المكان من حولها.
معتاد على مراقبة المكان من حولي في هذه الحديقة، أعرف كيف أسترق النظر دون أن تلاحظني لأرى من يحيط بالمكان، وإن كان يبدو من النوع الذي قد يكترث إن رآني أقبلها، استسلمت أخيراً لإغواء الجسد، لم يبدُ موجهاً للشفاه بالذات، تلك كانت بالنسبة لي تسجيل موقفٍ أكثر منها استسلاماً لشغف، أحطتُ بهزالتها بيدي، قربتها مني، تأكدتُ من الشعور بضغط عظامها وإكسسواراتها عليّ، طبعتُ قبلة رصينة على جبينها، وضممتها، وبعد دقيقة أو أقل، كان تنفسي قد فضحني، تحركتُ مبتعداً عن جسدها، وصمتُ صمتاً مميتاً.
علاقتي بالجنود أو الرجال الذين يمثلون السلطة في أي مكانٍ سيئة بشكلٍ عام، وفي هذه الحالة بالذات كانت رؤيتهم تستنهض عدة ذكريات كافية لأشعر ببعض القلق، حاولتُ إخفاء قلقي، والتوتر الذي يصيبني أمام أي سلاح، وارتباكي من التهام الأجساد في الأماكن العامة بعد أن نهرت عن ذلك قبل أن أتم الثامنة عشرة، كان عليّ أن أوصل رسالة فحواها: أنا أفحش منكِ، أنا خطرٌ على ما تبقى من الحضارة الإنسانية فيكِ.
قالت لي فيما بعد “احتويني، أنتَ رجل”، لم أستطع يوماً أن أستجيب كما يجب للتحريضات الطفولية التي تهدد لقب الرجولة عند الشرقي، ربما هي قلة إعجابي بـ”الرجل” الشرقية، أو هو التفسير المغاير للأغلبية الذي يراودني حين تقال كلمة رجل، ما زلتُ أدعو النساء بالفتيات أو البنات، في الروايات، وفي الشوارع الفرعية التي يسترق فيها المارة بعض الظل، هن نساء، ولكن داخل حياتي هن فتيات، فأنا ما زلتُ مراهقاً، ولا أنوي تغيير شيءٍ بهذا الخصوص.
المكان مكشوف، مغرٍ بقبلة لا تقبل نقاشاً، لم أبذل الكثير من الجهد، بدأ شغفٌ دون مقدمات – ككل شيء – وبعد ثوانٍ أدركتُ أن المكان ليس مناسباً لإطلاق العنان للارتعاشات التي بدأت تتشكل داخلي، كنتُ سأقول لها حين تطلب تقييماً – وفعلت – أنها […… ….. ……]، ولكني كنتُ كاتباً وقلتُ لها أن القبلة أعنف مما يجب، أعتقد أنني سأمسحها من هنا، الأمر لا يعدو كونه تفصيلاً سنلتفت إليه في حينه.
تذوقتُ لسانها، كان مالحاً، أثرٌ من المستحيل مسحه عن اللسان للبكاء إلا بقبلة أو بتنظيف أسنانك، لا يبدو أنها فعلت أياً من ذلك بين انتهاء بكائها ولقائي، من جديد، وجديد، وجديد، إصبعها تداعب شفتي طالبة الإذن بالدخول، تحاول أن تستفز خجلي، يبدو أنني لم أخفه كما يجب، لم أكترث، عضضتُ عليها وكالعادة، ذكرى ألم الأسنان هي أكثر ما يبقى لي من القبلات والنهود.
موعدنا غداً، يوم الثلاثاء الساعة السابعة، كان لا بد من ذكر الموضوع على الأقل، “سآتي، حتى لو لم تأتي”، سرتُ وأنا أفكر بالغد، قالت لي حين سألتها إن كان سبب تأخيرها موعدنا أسبوعاً كاملاً هو دورتها الشهرية؛ “ربما، فأنا أراك تترك باباً موارباً لفرجي”، كان ذلك الباب ما يخطر ببالي الآن، وأنا أسير مبتسماً، ملامساً شفاهي بلساني بشكلٍ دائم، أبتلع بهدوءٍ آثار ملوحتها في فمي، وأمني النفس بذلك الباب الذي أراه مفتوحاً أمامي على مصراعيه.
“الأمر أعمق مما يبدو عليه”، تتكرر تلك العبارة كصوتِ شبحٍ ملول في رأسي، امتنعتُ عن الحديث إليها بعد انتهاء لقائنا المعتوه، أتذكر تلك العبارة الآن من جديد، ما العميق في الموضوع؟ سوى الهراء الذي نتفوه به طيلة النهار، الأمر أعمق مما يبدو عليه، أنظر إلى ساعتي، الساعة السادسة وسبع وعشرون دقيقة، لم يراودني شكٌ – حتى حين أخبرتني أنها لن تأتي – بكونها لن تأتي، الأمر أعمق مما يبدو عليه، استسلمت لها في هذه المعركة، أيقنت أنها لن تأتي إلى موعدنا، يوم الثلاثاء الساعة السادسة.