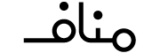الموت يحيط بنا من كل مكان، الليل يحمل لنا روائح الجثث وصرخاتها، يبعدنا قليلاً عن السكينة الحية التي اعتدناها، وتتراكم آلاف الأسماء في رؤوسنا، حتى نصل لمرحلة من الفراغ، من انعدام الحزن والتعاطف ولا يبقى سوى سؤالين نجيب أنفسنا عليهما كل لحظة من باب الفضول لا أكثر، هل ما زلنا أحياء؟ هل من نعرفهم ما زالوا أحياء؟ نعم؟ حسناً بإمكان الزمن أن يستمر بالمسير والناس أن تستمر بالموت.
أدار وجهه نحو النافذة وهذه الأفكار تدور في راسه، لم يعد فتح النافذة ينقذه من الحر، فالباص الصغير لا يتحرّك بسرعة، بل إنه لا يتحرك على الإطلاق، رتلُ من مئات السيارات أمامه، تنتظر دورها لتمرّ من الحاجز، لم يعد الأمر مسلياً، أو يضفي بعضاً من الإثارة إلى طريق منزله كما كان يفعل سابقاً، مد رأسه من النافذة ليرى كم هناك من السيارات أمامهم، كان هناك حوالي العشرين سيارة، ولمح الجندي يفتش صندوق سيارة، هذا يعني أن التشديد الأمني اليوم أكبر من المعتاد، وأن مدة الانتظار ستتضاعف، لم يأبه، أعاد رأسه إلى الداخل وأعاد تشغيل الأغنية التي لا يسمع غيرها منذ بداية الطريق ويعيدها منذ البداية كل مرة.
“لا أريد أن أسمع عنها، كل فردٍ لديه قصة ليرويها، والكل يعرف بها” *
سمع مئات إن لم يكن آلاف القصص، أسوأ حكايا الموت قد عرف بها، أسوأ طرق الموت قد سمع بها ورأى مقاطع مصورة لها، لم تعد تترك التأثير الذي كانت تتركه في البداية، باتت جزءاً آخراً من الكون ليس راضٍ عنه ولا يستطيع أن يقوم بشيءٍ لأجله، بالضبط كما هم بالنسبة له الأطفال الجياع في أفريقيا.
طال الانتظار، ومر وقتٌ طويل منذ تحرك الباص الصغير، أخرج رأسه من النافذة مرة أخرى كي يستقصي الأمر، كان الحاجز قد توقف عن السماح للسيارات بالمرور، حصل هذا الأمر عدة مرات على مرأى منه، وحتى اليوم لم يفهم لماذا يفعلون هذا، نادراً ما يكون هناك بالفعل ما يستأهل إغلاق الطريق.
لن أضيع من عمري المزيد من الوقت على الطرقات أو بانتظار فتحها، هذا ما فكر به، نهض عن كرسيه وترجل من الباص الصغير، سار وما زالت الأغنية تصدح في أذنيه، مضفية ما يشبه موسيقا تصويرية لطيفة على المشهد، كان يسير على قدميه كما يفعل بعض الآخرين حوله، يمر من سياراتٍ ثابتةٍ بلا حراك، الجنود على الحاجز يتحادثون، بانتظار قدرتهم – أياً كان مصدر هذه القدرة – على فتح الطريق، وواحدٌ منهم كان يتجادل مع شابين يريدان المرور على أقدامهم، كان واضحاً من هيئتهما أنهما من عمال البناء في الأبنية الجديدة التي تشيد على أطراف بلدته، تابع مسيره غير آبهٍ بكل شيءٍ حوله، كل ما كان يفكر به هو أن الوقت الذي هدره بانتظار المرور من الحواجز حتى الآن أكثر من كافٍ، وعلى هذا الهدر أن يتوقف في الحال.
“سأقوم بصدهم، جيش سبع أممٍ لم يستطع أن يوقفني” *
كان يعرف أن الجنود على الحاجز لن يسمحوا له بالمرور، ولكنه لن يستسلم، عليه أن يوفر بعضاً من الوقت، حضرته مشاهدٌ من مسلسل عمر، كيف كانت تجري المعارك، حينها كان الجنود رجالاً، كانوا يتواجهون وجهاً لوجه، كان القاتل ينظر في وجه الضحية قبل قتلها، كان عليه أن يكون قوياً كي يقتل، وضعيفاً كي يموت، اليوم الأمور مختلفة، هؤولاء الجنود قد يموتوا دون أن يعرفوا أو يروا وجه من قتلهم، وكذلك قد يصوبون قذيفة واحدة ويقتلون عشرة رجالٍ آخرين دون أن يعرفوا من قتلوا، ودون أن يعرفوا إن كانوا قد قتلوا أصلاً، حروب اليوم مملة، ليس فيها ما يكفي من الضغط وما يكفي من متابعة الموت بالعين المجردة، لا عجبَ أن الجيشين لا يملان من القتل، هم لا يرون وجوه ضحاياهم ولا وجوه قاتليهم، الحرب اليوم باتت أشبه بألعاب الفيديو، ولكن مع بعض الأدوات الإضافية للوحة المفاتيح والفأرة الإلكترونية والشاشة.
مر من قرب الجندي، لم يبعد السماعات عن أذنيه، مر وكأن لا شيءَ بقربه يستدعي التوقف، كان الجندي قد أصبح وراءه، لم يتكلف عناء خلع السماعت من أذنيه، تابع السير، قرر أنه لن يتوقف مهما حصل، إلى أن حصل ما لم يكن يتوقع أن يحصل، كان الجنود ينادون عليه، ولكنه لم يكن يجيب، قام أحدهم بإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء، صوت الرصاصة استطاع أن يعبر الموسيقا التي تملأ أذنيه.
توقف، لم يرد أن يتمادى باستفزازهم أكثر من ذلك، ظل واقفاً في مكانه، لم يلتفت نحوهم، كان ينتظر أن يأتيَ أحدهم كي يكلمه، كان ينتظر أن يحاصره بعض الجنود الخائفين من كونه مفخخاً أو شيئاً من هذا القبيل، لم يفكر بما عليه أن يقول، هذا ما أخبرته إياه الأغنية التي ما زالت تتكرر في رأسه.
“كل الكلمات ستنزف مني، ولن أفكر بعد الآن” *
شعر بإصبعٍ تنكزه على كتفه، أدار وجهه قليلاً كي يرى الإصبع، آه! ليست إصبعاً، إنها سبطانة كلاشينكوف، التفت نحو الجندي، أزال السماعة المثبتة على أثنه اليسرى وترك الأخرى على اليمنى، ترك الأغنية مشغلة كي لا تتوقف الموسيقا التصويرية عن هذا المشهد الدرامي الذي يمر به.
– ألا ترى الحاجز؟
– بلى..
– لماذا لم تتوقف أو تبرز بطاقتك الشخصية؟
– لم أجد داعٍ لذلك..
– هل تعلم أني أستطيع أن أضعك في السجن الآن؟
– اِفعل، لن أمنعكَ
– لو استمريتَ بالسير دون أن تجيب على ندائي كان من الممكن أن أقتلك… لدي الصلاحية كي أقوم بذلك.
– أيضاً لن أمنعكَ، اِفعل الآن إن شئتَ.
– أعطني بطاقتكَ الشخصية… سأتغاضى عن وقاحتكَ.
– لا تتغاضى عن وقاحتي، لستَ مضطراً، كما أنني لن أعطيكَ بطاقتي الشخصية.
– لماذا تعقد الأمور؟
– صورتي على البطاقة الشخصية لا تشبهني، كما أني قبيحٌ جداً في هذه الصورة.
– حسناً… تابع سيركَ ولا تتهور بهذا الشكل مرةً أخرى.
“والبقع الآتية من دمي تقول لي اِذهب إلى المنزل” *
تابع سيره غير مهتمٍ بفهم السبب، ولكنه عرف أنه منذ اليوم عليه كي يتفادى الموت أن يتوقف عن الخوف منه، وأن يتوقف عن التأكد كل لحظة من أنه على قيد الحياة، فالتجربة علمته أنه حين يموت، أو يموت أحد أصدقائه سيعلم دون أن يضطر للسؤال، هؤولاء الجنود ليسوا استثناءً، فمن لا يخاف الموت لن ينفع قتله في شيء، هم يفهمون هذه القاعدة ولذلك تركوه وشأنه.
فيما كان الجندي الذي لكزه بسبطانة الكلاشينكوف يعود متهادياً نحو الجنود الآخرين الذين ما زالوا يسدون الطريق في وجه السيارات، قال له جنديٌ آخر “لماذا تركته؟”، قام بإرخاء حزام البندقية فتوجهت إلى الأرض بدلاً من السيارات، التفت إليه وكأنه يخبره أمراً بديهياً عليه أن يعرفه بنفسه، قال له وهو يخرج علبة السجائر من جيب سترته عند صدره “شخصٌ بهذه الوقاحة لا بد أن يكون ابن مسؤولٍ كبير، لا أريد أن أقع في المشاكل”.