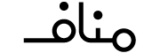كنتُ في غرفتي أختبئ منه، أخاف أن يدخل غرفتي ، أن يعلم أنني مازلتُ أتنفس، أن يعلم أنني مازلتُ فتاة، راكعة على الأرض، أرتدي الثوب الأبيض وغطاء الرأس. إذا دخل يكفيني أن أدّعيَ الصلاة فتتأخر المعركة لدقائق، لا أدري إن يصح أن أدعوَها معركة، فالمعركة بين عدوّين، أنا وهو لا يُسمح لنا بأن نكون عدوَين، المعركة بين ندّين، وأنا أبداً لم أكن ندّاً له، أنا لستُ سوى دمية أو كيس ملاكمة بين يديه، كنتُ ربما آلة لأحتواء غضبه، لابتلاع غضبه.
في داخلي شيءٌ من الغضب، في داخلي شيءٌ من الضجر، أحتاج لدميةٍ كي تبتلع غضبي، أحتاج أن أتقيأ بعضاً من الغضب الذي أبتلعه. القاعدة هي أن الذي يبتلع الغضب هو العنصر الأضعف في المعادلة، أبحث في غرفتي عمّا هو أضعف مني.
كرسي… لا، أنا أضعف من كرسي.
وسادة… لا، أنا ألين من وسادة.
علائق، ستائر، ملابس. أنا أضعف من ذلك كله، الخوف حولني إلى قزم، جعلني أصغر وأضعف من كل المخلوقات، من كل الكائنات الحيّة والميتة.
ورقة …
نعم تلك أضعف، تلك أصغر مني، تلك تليني في السلم، قدرها أن تبتلع غضبي، بحثتُ عن أوراق لا أملكها.
بعد أن هجرتُ العلم لم أعُد أملك أي أوراقٍ، القدر جعلني في بلدٍ تهدي الفتاة تعليماً إلزاميّا حتى الابتدائيّة، وتهديها بيتاً يكره الذين يخرجون منه سوى إلى بيت الطاعة أو القبر.
بحثتُ في غرفتي، لم أجد سوى الملابس والدّين.
الكتاب الوحيد الموجود في غرفتي هو القرآن، مسجلة عُطل فيها المذياع، وأشرطة لسور القرآن، فبرأي فزاعتي الغناء حرام، والاستماع للأغاني حرام، وقراءة أيّ كتابٍ سوى القرآن – أبلغ الكلام – أيضاً حرام.
القرآن…
نسخة القرآن التي لديّ في آخرها ورقة بيضاء، ليس لي سواها مساحة فارغة تستوعب غضبي، ليس لي سواها معدة فارغة تحتوي تقيّؤي، في المشرق العلاقاتُ فيه كلها تقيؤ، فالحكام محكومون بفقر بلادهم، يتقيّؤون غضبهم في أفواه أتباعهم، أتباعهم قبل ابتلاع القيء يتقيّؤونه في أفواه الموظفين الصغار، الموظفون الصغار يتقيّؤون همومهم في أفواه عوائلهم وأبناهم، كلٌ يتقيؤ بطريقته الخاصة، قد يكون التقيؤ على صفحة بيضاءَ مزّقت من آخر نسخة القرآن.
أمسكتُ الورقة، والقلم الذي أستعمله لأكتب لوالدي على دفتره حاجياتي لمهنتي الوحيدة، الطبخ.
بدأتُ بالكتابة دون خوفٍ :” أنا أكتبُ هذا لأنني حزينة، ولأن السبب في حزني هو في كل العالم سبب السعادة، فأنا منذ كان عمري خمس سنوت….”
شيءٌ في داخلي بدأ يرتجف، ربما كان قلبي، ربما كان ضميري، ربما كان شعورٌ زائف بالذنب بدأ يراودني، ولكنني قررتُ ألا أهتم وأستمر بالكتابة.
“… منذ كان عمري خمس سنوات أجبرني على ارتداء الحجاب، ولم يكن يسمح لي بالنزول إلى الحارة لألعب مع رفقاتي، وبعد أن ماتت أمي لم يكن أبي يحكي لي قصصاً كما كانت تفعل أمي عائشة، ولم يكن يتكلم معي، ولم يسمح لي بزيارة أحد..”
هل أكمل؟ ماذا لو أمسك بالورقة؟ قد يقتلني؟ قد يقتلني لأسبابٍ أتفه بكثير من هذه الورقة؟ هل أفوّت الفرصة ربما الوحيدة في حياتي كي أتقيّأ؟
“.. كانت عمتي فقط تزورني لتعلمني لطبخ وأعمال المنزل، أمّا الآن فحتى عمتي لا أراها سوى في السنتين أو الثلاث مرّة، حين نذهب لنبارك بحجاتها اللائي تجاوزن الخمسة ربما، فزوجها ليس فقيراً كوالدي ويقدر أن يدعها تسافر…”
سمعتُ خطوات الفزاعة تقترب من غرفتي، ودبّ الخوف في داخلي، أحسستُ بعروقي ترتجف، ولم أعلم ما أفعل بالورقة، فكرتُ بتمزيقها، ولكن عز عليّ أن أفعل ذلك، فتلك هي صديقتي الأغلى الآن، وإليها أخلي همومي كما تفعل الصديقات، طويتها كيفما تيسّر ودسستها بين نهديّ، مهما شك لن يتجرأ أن يبحث هنا.
جلستُ على ركبتي ورفعتُ رأسي للسماء فاتحة يديّ وتربطهما مسبحة خشبيّة ببعضهما….
يدخل فزاعتي، يطلب مني بصوتٍ منخفض أن أنهي صلاتي سريعاً لأنه يريد التحدّث معي، أثناء انتظاره رنتْ سماعة الهاتف في غرفتي، رنت رنة واحدة وصمتتْ، على الطرف الثاني من ذاك الاتصال ربما كان طفلٌ ينظر إلى التلفاز ويتصل بصديقه في نفس الوقت، وحين ضغط الرقم أخطأ بأحد الأرقام، وحين أدرك بعد الرنة الأولى أغلق السماعة فوراً.
و ألف احتمالٍ آخر قد يجعل هاتفاً في غرفة فتاة تصلي وأبوها ينتظرها لتنتهي يرن رنة واحدة.
بعد تلك الرنة سيطرتْ الفزاعة، الوحش خرج من داخله، ذلك الشخص المريض خرج، نظر إليّ، وطلب مني منتهراً أن أنهي صلاتي :” هيا، خلصيني!”
اضطررتُ حينها أن أنطق عبارة السلام عليكم لأنهي صلاتي المدّعاة فوراً، دون أن أقوم عن ركبتي سألته:” نعم يا والدي.”
” من الذي كان يتصل؟ هل كان الاتصال لكِ؟”
” لا أدري، ومن سيتصل بي؟”
لا أعلم إن كان جوابي سيقنعه، أسوأ ما في طبيعة الضعفاء أنهم حين يكونون بريئين من التهم التي توجه إليهم يعجزون عن التصرف على طبيعتهم، ويضطرون أن يمثلوا أو يصطنعوا دور البريء، لا أعلم إن أقنعه تمثيلي حينها، ولكني لم أغيّر جلستي عن الركوع على الركبتين، كمن ينتظر أن يطلب منه خفض رأسه ليطبق عليه حكم الإعدام.
” ولماذا تجيبين بهذه الطريقة…؟”
” أي طريقة تلك؟”
” اصمتي…!”
لم أرها، ولكنني شعرتُ بها تغطي الجانب الأيمن من وجهي، يرتطم كتفي الأيسر بالأرض وأسمعُ صراخاً، لا أفهم ما يقال فقد سُدّت أذني من صفعته.
عاد الهاتف ليرن ثانية، نظر إليّ متوعداً وذهب ليجيب، حينها انتبهتُ إلى الورقة وقد وقعتْ مني، تناولتها، وفكرتُ كيف أخبئها قبل أن ينتهي الاتصال.
كان اتصالاً من متجره يخبرونه بوصول بضاعةٍ كان ينتظرها. لا أعلم إن كان عليّ أن أخبئها مجدّداً بين نهديّ، وضع يدي في ذلك المكان بحضوره ستعتبر وقاحة أستحق الموت لأجلها، لم أعلم ماذا أفعل، كنتُ أدير ظهري له فلا يرى الورقة، تحتويها يدي، تخبئها مؤقتاً ريثما أجد لها مكاناً آخراً، وفجأة سمعتُ صوت السماعة تغلق، وقدماه تتجه نحوي، ولا أدري أين أذهب بها.
خفضتُ رأسي منتظرةً الضربة الثانية على رأسي، وصارت يدي قريبة من فمي، لم أفكر، وجدتُ أمامي حلاً وفقط، حشرتها في فمي، ابتعلتها في ظرف ثوانٍ، لم تكن شهيّة، كنتُ أرتجفُ من شعور ابتلاع الورق.
وقف بجانبي دون النظر إليّ، قال أنه ذاهبٌ إلى العمل، ورحل دون اعتذارٍ، دون أن يتابع ما بدأ، رحل وحسب، غير مهتماً بما تركه مكوّماً على الأرض.
ما تقيّأته ابتلعته، وابتعلتُ من ابتلعه، وبقيتُ فتاة لديها أبٌ، تعيش معه، وتبتلع القيء لأجله.