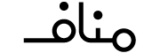ذلك النهار…
كنتُ أسير متجهة إلى أمام مكان عمله منتظرة أن يلاقيني في منتصف الطريق، اتصلت به لأخبره أنني أقترب، قال لي أنه بانتظار صديقة يريد أن يعرفني عليها، تابعت سيري ولم أهتم كثيراً بالأمر، وصلتُ قريباً من عمله… وكان واقفاً هناك مع فتاة نحيلة، متوسطة الطول شقراءَ الشعر، خضراء العينين.
لم أشعر بالغيرة منها فقد كان من الواضح أنها تكبره بالعمر على الأقل بخمس سنوات، اقتربت منهما، طبعتُ قبلة على خده وصافحتها؛ “هذه بانة الأحمر… أخبرتكِ عنها”، نعم بالطبع أخبرني عنها، كان قد حدثني لساعات عنها، تكبره بست سنوات، وناجحة حد التخمة في عملها القانوني. لا بد أنه دعاها ليعرفني بها، ليجعلني أرى أن هناك من هي أكثر نجاحاً مني، ولكن لم أفكر في ألأمر كثيراً حينها.
صعدنا في سيارتها الزرقاء – زرقاء بشكل مزعج – وتحركنا باتجاه المدينة القديمة حيث كنا ننوي أن نذهب أساساً، وفي الطريق كان لا ينفك يخبر كل واحدة منا ملايين الأمور عن الأخرى، وبين الخبر والآخر يتوقف قليلاً ليرفع من صوت المذياع، ويبدأ بإخبارنا عن هذا المغني وتلك المغنية ويصف معظمهم بأنهم “اللـه” من شدة إعجابه بهم.
وحين كان يغني مع أحد المغنين رن هاتفه، رد دون أن يخفض صوت المذياع…”أهلاً.. جيد الحمد للـه… ثواني من فضلكِ”، وأشار لبانة بأن تطفئ المذياع، وحين تابع الحديث على هاتفه كنا قادرتين على سماع صوت الفتاة التي تحدثه..
– كنتُ أسألك عن العشاء الذي تنوي أنت وسارة تنظيمه لطلاب صفنا في الصف السادس، هل مازال قائماً؟
– نعم مازال… هل ترغبين بالقدوم؟
– نعم..
– لا بأس.. ولكن لم أعلم من يحدثني؟
هنا لم نعد نستطيع سماع صوتها، ولكنه فجأة بدأ بالحديث بعصبية؛ “ليس ذلك النوع من المزاح الذي أفضله.. ما الغريب في الأمر؟ حسناً إن كنتِ حقاً لما الرفاعي أعطني علامة تؤكد لي ذلك..”
كان قد بدأ بالنظر إلى أعلى حينها، وعاد صوت الفتاة مرتفعاً ووصل إلينا من جديد كانت تقول: في الصف الخامس كنتَ أنتَ وحسن توصلنا أنا وريم إلى منازلنا وتنتظرانا حتى نخرج إلى الشرفة وتتحدثان إلينا قليلاً.
رمى الهاتف إلى جانبي – كنتُ أجلس في المقعد الخلفي – وأشار لبانة بأن توقف السيارة، توقفت بانة بالسيارة إلى يمين الطريق في مكانٍ لا يعرضنا لخطر الاصطدام بسيارات أخرى، حين توقفنا نزل بسرعة من السيارة، ركع على الطريق وضع يديه عل الرصيف وأخذ يتنفس كمن يلفظ أنفاسه الأخيرة..
اقتربتُ منه محاولةً أن أفهم منه ما الذي جعله على هذا القدر من الارتباك.. ولكنه لم يكن يجيب بشيءٍ سوى “لما الرفاعي.. لما الرفاعي”، لم أفهم من تكون هذه الفتاة، ولكن اسمها لم يكن غريباً علي وكنتُ متأكدة من أني سمعته قبلاً منه ولكن لا أذكر ما الذي كان الأمر الذي أخبرني إياه عنها.
أخرجتُ هاتفي واتصلتُ بأحمد صديقه، فهو لا بد يعلم شيئاً ما عن هذه الفتاة، وكنتُ بأمس الحاجة لأعرف شيئاً سوى اسمها، ما من طريقة أخرى لأتمكن من تقديم يد العون له…
– مرحباً
– أهلاً
– أجبني سريعاً.. لما الرفاعي، من تكون هذه الفتاة؟
– صديقتنا من المدرسة الابتدائية، لماذا تسألين عنها؟
– لأنها اتصلت به منذ قليل وهو…
– ماذا؟ تقولين اتصلت به؟
– نعم… لماذا؟
– لا بد أنه مزاح من العيار الثقيل… لا يمكن أن تكون هي المتصل.
– حسناً… استخدم كلمة المزاح، ولكن لم أفهم لماذا.
– لأن لما الرفاعي ميتة منذ حوالي السبع سنوات.
– هذا ما أخبرني به.. الآن تذكرت ذلك.
– أين أنتم الآن؟
– في شارع بغداد بالقرب من… مركز البريد.
– عشر دقائق وأصبح عندكم.
– حسناً…
بانة كانت تهمس في أذنه، تحاول تهدئته ولكن تنفسه بدا أنه يصبح أصعب، كان يختنق كل عدة ثوانٍ، وبانة تقول أشياءً في أذنه ربما كانت معتادة على قولها حين تحاول تهدئته ولكن هذه المرة يبدو أنها لم تفلح في جعله أقل ارتباكاً، بدأتُ أشعر بالخوف من أن يختنق ولا يستطيع التنفس و… يموت.
جاء صديقه، وصل إلينا، سألنا ما الذي حصل، قلنا له عن الاتصال الذي حدث والحالة التي أصابته، سألنا عدة مرات؛ هل أنتما متأكدتان أن الاسم الذي سمعتناه هو لما الرفاعي؟، وكررنا جوابنا عدة مرات… أنا أقول له نعم وبانة الجبانة تقول لستُ متأكدة ولكني أظن أن هذا هو الاسم.
أخذ أحمد هاتفه واتصل بآخر رقمٍ أتاه ولكن من هاتفه (هاتف أحمد) في محاولة لكشف خدعة ما، أجابت فتاة عليه، سألها أحمد عدة أسئلة ولكن لم يبدُ بذات درجة التفاجؤ التي أصابت حبيبي، ربما لأنه قد سمع الخبر – وإن لم يكن مؤكداً – مسبقاً، أو ربما لأنه عرف هذه الفتاة لسنة واحدة في نفس المدرسة على عكس حبيبي الذي قضى معها سنوات المدرسة الابتدائية الست.
وأخيراً سمعنا جملة لم تكن مريحة لنا..”حسناً كوني هناك بعد ساعة من الآن، وحاولي ألا تتأخري فوضعه سيئٌ جداً ولا بد أن يفهم ما هذا الذي يحصل”
نظر إلينا وقال: سنلتقيها بعد ساعة من الآن في أحد مطاعم دمشق القديمة، هل تودان الذهاب؟
بانة قالت أنها تريد القدوم، لا بد وأنها كانت تريد أن تعرف المزيد عن هذا الأمر لتجد أخيراً فكرة تكتب عنها زاويتها الأسبوعية في تلك الجريدة اللبنانية، أما أنا فقلتُ له دون تردد (سواء في الخارج أو الداخل): بالطبع سأذهب معكم، لن أتركه بهذه الحالة وحيداً، لا أعني أنه سيكون وحيداً وهو معك ولكن أشعر به وحيداً ما دمتُ لستُ بقربه.
أوصلتنا بانة إلى الكراج الموجود قريباً من ساحة باب توما، وأكملنا المسير باتجاه المطعم – أو بالأحرى المقهى – الصغير الذي اختاره أحمد لنلتقي بهذه الـ”لما” ونعرف ما بها.
جلسنا وكان حبيبي صامتاً كالموت، كان هادئاً بحيث أنك بالكاد تسمع تنفسه، ولم يكن الأمر مريحاً، فبعد ضيق التنفس الذي أصابه هناك كنتُ أتأكد كل عدة ثوانٍ أنه مازال يتنفس، أما أحمد فكان ينظر باتجاه الباب باستمرار منتظراً قدوم لما التي يحاول أن يتذكر ملامحها بالضبط، فهو لم يلتقيها إلا عدة مرات في السنوات الإحدى عشر التي تلت افتراقهم بعد الابتدائية.
دخلتْ فتاة ممتلئة الجسم بشكل لطيف، ذات بشرة بيضاء كالثلج وعينين سوداوين كالليل، ترتدي ملابسَ متخمة بالأناقة وحذاءٌ يذكر بكونتيسات العصور الوسطى، وصلت إلى أمام طاولتنا، وقفت بهدوءٍ أمامنا، وكان واضح أنها لم تتعرف سوى وجه حبيبي، أما وجه أحمد فلم تتعرفه.
نظر حبيبي إليها بهدوءٍ، مد يده لمسَ مفاصل يدها، وضعها على بطنها، ومن ثم وقف واقترب منها واشتمها، وعلى الرغم من أن الغيرة بدأت تتحرك في بعض الشيء إلا أن رؤية فتاةٍ قادمة من الموت كان يستحق إشباع فضول الحواس الخمس.
فجأة ارتعش جسمه وتراجع إلى الوراء وعاد ليجلس بعد أن أشاح نظره عنها وطلب منها الجلوس بإشارة من يده.
نظرتْ إلى أحمد وتذكرتْ وجهه؛ “أحمد.. أليس كذلك؟ لقد تغير شكلك كثيراً”.
نظرتْ إلى حبيبي وقررت أن تبدأ بالشرح له فوراً، فهي تعلم أن نبأ وفاتها الذي تلقاه منذ سبع سنوات لم يكن سهلاً عليه بعد الوقت الجميل الذي قضياه سوياً في الابتدائية.
“الأمر ببساطة أنني مسلمة… في تلك السنة كنتُ قد قضيتُ ليلة مع شابٍ مسيحي، ليلة فقدت فيها أغلى ما أملك، الأغلى بنظر من حولي على الأقل، وهذا الشاب لم يكن نذلاً وأبدى استعداده للزواج مني في الحال، ولم نستطع أنا وهو الزواج ببساطة بسبب معارضه أهلينا لاختلاف الدين بيننا، ولكن بعد عدة أسابيع بدأت تظهر أعراض حملٍ عليّ، وحينها لم يستطع شادي – هذا اسم الشاب بالمناسبة – أن يعرض حياتي للخطر أكثر من ذلك، قمنا بالهرب سوياً إلى فرنسا باعتباره يحمل جنسيتها، ولم أتجرأ منذ حينها على الاتصال بأهلي أو بأي أحدٍ قد أكون على معرفة به.. منذ حوالي السنة عدنا إلى سورية وتبين لي أن أهلي قد لفقوا قصة حول غيابي تحميهم من عيون الناس وأحكامهم… لم يخبروا أحداً أنني وقعتُ في الحب.. بل أخبروا الجميع أنني متُ، كان أهون عليهم أن أموت من أن أكون فقدتُ عذريتي قبل الزواج، وأن أقوم بالزواج من دون أذنهم، وأخيراً أن أرتبط بشابٍ ليس من طائفتي.. يا ليتني متُ حقاً ولم أرَ تلك الصدمة التي أراها على وجهك الآن لمئات المرات كل يوم”.
إلى الذكرى الجميلة لـ ل.ق… غيابكِ يؤرقنا كل يوم.